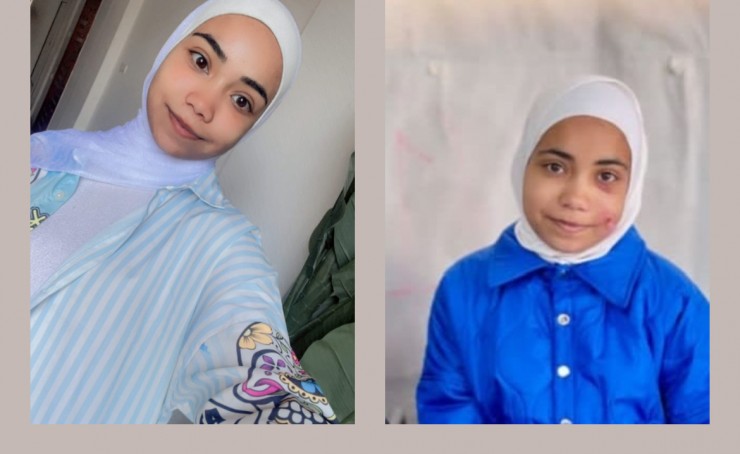قوات الاستقرار الدولية في غزة: مشروع أميركي بثوبٍ أممي... سلامٌ أم وصايةٌ جديدة؟
بي دي ان |
07 نوفمبر 2025 الساعة
12:52ص
 الكاتب
منذ عامين، والمشهد الفلسطيني، بشكلٍ عام، والغزّي بشكلٍ خاص، يطفو على سطح النقاشات الدولية بين نار الحرب وبارود السياسة. وبينما يئنّ قطاع غزة تحت الركام والدمار، خرجت واشنطن - كعادتها - بخطتها الجديدة: "قوات الاستقرار الدولية في غزة"، لتكون - كما تصفها - مرحلةً انتقاليةً نحو الهدوء وإعادة الإعمار. لكن، خلف اللغة الدبلوماسية المنمّقة، يختبئ مشروعٌ استراتيجيٌّ ضخمٌ وبالغُ الخطورة، يُعيد تعريف من يملك الحق في إدارة أراضي الدولة الفلسطينية بشكلٍ عام، وفي قطاع غزة بشكلٍ خاص، ومن يرسم ملامح مستقبلها.
الكاتب
منذ عامين، والمشهد الفلسطيني، بشكلٍ عام، والغزّي بشكلٍ خاص، يطفو على سطح النقاشات الدولية بين نار الحرب وبارود السياسة. وبينما يئنّ قطاع غزة تحت الركام والدمار، خرجت واشنطن - كعادتها - بخطتها الجديدة: "قوات الاستقرار الدولية في غزة"، لتكون - كما تصفها - مرحلةً انتقاليةً نحو الهدوء وإعادة الإعمار. لكن، خلف اللغة الدبلوماسية المنمّقة، يختبئ مشروعٌ استراتيجيٌّ ضخمٌ وبالغُ الخطورة، يُعيد تعريف من يملك الحق في إدارة أراضي الدولة الفلسطينية بشكلٍ عام، وفي قطاع غزة بشكلٍ خاص، ومن يرسم ملامح مستقبلها.
ماهية "قوات الاستقرار الدولية"
على الورق، تحمل هذه القوة اسماً يوحي بالسلام، لكنها ليست قوات سلامٍ أممية بالمعنى التقليدي الذي عرفناه في لبنان أو قبرص أو جنوب السودان. فقوات حفظ السلام تعمل عادةً بموافقة الأطراف المتنازعة، وتلتزم الحياد، وتكتفي بمراقبة وقف إطلاق النار، ولا تُطلق النار إلا دفاعاً عن النفس، وبموجب الفصل السادس ونصف (قوات هجينة) وفق قرارٍ من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ويفترض أن تكون محايدة. أما قوات الاستقرار الدولية المطروحة في مسودة القرار الأميركي، والمبنية على خطة توني بلير لإدارة غزة، فهي أداة تنفيذية قسرية تُنشأ عادةً بقرارٍ من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي أنها تمتلك صلاحية استخدام القوة لفرض النظام، ونزع السلاح، وتسريح القوات ودمجها، والسيطرة على الأرض والمعابر تحت إمرة المجلس التنفيذي (مجلس السلام)، ويديرها مفوض الأمن من خلال مركز التنسيق الأمني والعسكري. بمعنى آخر، هي ليست حارسَ سلامٍ، بل مشرفةُ مرحلة؛ وليست مراقباً محايداً، بل فاعلاً في قلب المعادلة السياسية والأمنية. والفرق الجوهري، إذن، أن قوات الاستقرار ليست أداةً لحماية المدنيين، بل وسيلةً لإعادة هندسة المشهد السياسي والديمغرافي.
مقارنة الفصل السادس بالفصل السابع
يشكّل الفصلان السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة نظام التدخّل الأممي لحلّ النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والإخلال بالأمن والاستقرار الدوليين. وقد تضمّنا إجراءاتٍ وتدابير ووسائل تعتمدها الأمم المتحدة لإقرار السلم والأمن. فالفصل السادس، في مواده من (33–38)، ينصّ على دور مجلس الأمن في دعوة الدول إلى تنفيذ الوسائل السلمية لحلّ النزاعات الدولية من خلال المفاوضات، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية. وتتصف قرارات مجلس الأمن هنا بكونها غير إلزامية.
أما الفصل السابع، فينصّ على التنفيذ القسري لقرارات مجلس الأمن، ويتضمّن استخدام وسائل القوة لحلّ النزاعات التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين. وأهمّ مواده (39–41–42)، وهي لبّ موضوع الفصل، إذ تُجيز استخدام أشكال القوة سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو الحصار أو الوسائل العسكرية. ويعمل مجلس الأمن، بغية تنفيذ قراراته، على تطبيق تدابير وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات والعلاقات الدبلوماسية جزئياً أو كلياً، وفي حالة عدم نجاعة هذه التدابير، يلجأ إلى دعوة القوات العسكرية التابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والموضوعة تحت تصرّفها، للعمل على إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، بموجب المادتين (41، 42). كما يمكن لدولٍ غير أعضاء أن تساهم في تنفيذ قرارات المجلس وفق الإجراءات التي نصّت عليها المادتان (43، 44).
المشروع الأميركي... ما وراء العناوين
منذ السابع من أكتوبر 2023، تعمل واشنطن على تسويق فكرة أن غزة بعد الحرب تحتاج إلى "مرحلة استقرار"، لا إلى انسحابٍ فوري، ولا إلى عودةٍ كاملةٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية. والمشروع الذي صاغته وزارة الخارجية الأميركية، وأعيد صياغته على طاولة مجلس الأمن، إذ يقترح نشر قواتٍ متعددة الجنسيات بقيادة دولٍ "محايدة" – مثل كندا والدنمارك، وربما دولٍ عربية – لإدارة الشأنين الأمني والإغاثي داخل غزة.
لكن، خلف هذا الطرح الإنساني الظاهري، يكمن جوهرٌ استراتيجيٌّ أعمق: تقليص الدور الفلسطيني في إدارة ما بعد العدوان، وتوفير مظلّةٍ قانونيةٍ لإسرائيل لتجنّب مسؤولية الاحتلال، وخلق واقعٍ سياسيٍّ جديد يجعل غزة منطقةً تحت إشرافٍ دوليٍّ غير مباشر. إنها، باختصار، وصايةٌ سياسيةٌ دوليةٌ بأدواتٍ أمنيةٍ واستثمارية.
المخاطر على الوعي والسيادة الفلسطينية
1. المسّ بالسيادة الوطنية: أي وجودٍ عسكريٍّ أجنبي، مهما كان علمه أزرقاً أو براقاً، هو خصمٌ من مفهوم السيادة إذا لم ينبثق من إرادةٍ فلسطينيةٍ خالصة مدعوم بقرار المنتظم الدولي.
2. التطبيع مع السيطرة غير المباشرة: قد تتحوّل القوة إلى "غطاءٍ قانوني" لإدامة هيمنة الاحتلال، بحيث يبقى قطاع غزة "هادئاً ومفتوحاً"، ولكن دون حريةٍ حقيقية أو سيادةٍ فعلية.
3. تحويل المعاناة إلى إدارة: الخطر الأكبر أن تصبح أزمة غزة مجرّد ملفٍ إداريٍّ تتناوله اللجان الدولية بالميزانيات لا بالعدالة، فتغيب الجذور السياسية للصراع.
4. التأثير على الهوية الوطنية: جيل ما بعد الحرب قد ينشأ على واقعٍ جديد يرى في "القوات الدولية" سلطةً فوق وطنية، وهو ما يهدّد الوعي الجمعي الفلسطيني ويضعف روح المقاومة المدنية والسياسية.
أين يقف الفلسطينيون من هذه المعادلة؟
يقف الشعب الفلسطيني اليوم أمام مفترقٍ دقيقٍ بين أمنٍ مفروضٍ وسيادةٍ منتزعة. فإن أُنشئت هذه القوة بموافقةٍ فلسطينيةٍ صريحة، وتحت إشرافٍ أمميٍّ حياديٍّ حقيقي، وبهدف تمكين الفلسطينيين لا تقييدهم، فقد تكون خطوةً مرحليةً ضروريةً نحو إعادة البناء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. لكن، إن جاءت مفروضةً من الخارج، تقودها إرادةٌ سياسيةٌ لا ترى في غزة سوى "منطقةٍ أمنيةٍ واستثمارية"، فإنها ستكون حكماً نظامَ وصايةٍ جديداً بوجهٍ ناعمٍ ويدٍ حديدية.
خاتمة: ما بين الأمن والكرامة
القضية ليست في لون العلم الذي سيرفرف فوق غزة الفلسطينية، بل بمن يملك القرار على الأرض. قد يأتي الهدوء والسلام مؤقتاً مع هذه القوة، وقد يعود الأمن إلى بعض الشوارع، لكن الكرامة الوطنية لا تُدار عبر بندقيةٍ أممية، بل تُبنى بإرادة الشعوب. فالولايات المتحدة، التي تسوّق اليوم لفكرة "الاستقرار"، تبحث في الحقيقة عن أمن للاحتلال من جهة، وعن الاستثمار في مشاريع ضخمة وفق خطة كوشنر-ويتكوف من جهةٍ أخرى، عبر استغلال مقدّرات الشعب الفلسطيني في القطاع (الغاز، البترول، والأرض). وبالطبع، لا تبحث عن سلامٍ لشعبنا الفلسطيني، علماً بأن الضفة الغربية بعيدةٌ كلّ البعد عن مختلف المشاريع الأميركية (ترامب، بلير، كوشنر- ويتكوف) وهذا يعتبر تكريس فصل جغرافي بين غزة والضفة بما فيها القدس. لذلك، فإن الفلسطينيين أمام اختبارٍ تاريخيٍّ جديد: هل يقبلون بسلامٍ بلا سيادة؟ أم يصنعون استقرارهم بكرامةٍ وسيادةٍ من داخلهم؟
جمال أبوغليون
[email protected]
6/11/2025
بي دي ان |
07 نوفمبر 2025 الساعة 12:52ص
 الكاتب
الكاتب
ماهية "قوات الاستقرار الدولية"
على الورق، تحمل هذه القوة اسماً يوحي بالسلام، لكنها ليست قوات سلامٍ أممية بالمعنى التقليدي الذي عرفناه في لبنان أو قبرص أو جنوب السودان. فقوات حفظ السلام تعمل عادةً بموافقة الأطراف المتنازعة، وتلتزم الحياد، وتكتفي بمراقبة وقف إطلاق النار، ولا تُطلق النار إلا دفاعاً عن النفس، وبموجب الفصل السادس ونصف (قوات هجينة) وفق قرارٍ من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، ويفترض أن تكون محايدة. أما قوات الاستقرار الدولية المطروحة في مسودة القرار الأميركي، والمبنية على خطة توني بلير لإدارة غزة، فهي أداة تنفيذية قسرية تُنشأ عادةً بقرارٍ من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي أنها تمتلك صلاحية استخدام القوة لفرض النظام، ونزع السلاح، وتسريح القوات ودمجها، والسيطرة على الأرض والمعابر تحت إمرة المجلس التنفيذي (مجلس السلام)، ويديرها مفوض الأمن من خلال مركز التنسيق الأمني والعسكري. بمعنى آخر، هي ليست حارسَ سلامٍ، بل مشرفةُ مرحلة؛ وليست مراقباً محايداً، بل فاعلاً في قلب المعادلة السياسية والأمنية. والفرق الجوهري، إذن، أن قوات الاستقرار ليست أداةً لحماية المدنيين، بل وسيلةً لإعادة هندسة المشهد السياسي والديمغرافي.
مقارنة الفصل السادس بالفصل السابع
يشكّل الفصلان السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة نظام التدخّل الأممي لحلّ النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والإخلال بالأمن والاستقرار الدوليين. وقد تضمّنا إجراءاتٍ وتدابير ووسائل تعتمدها الأمم المتحدة لإقرار السلم والأمن. فالفصل السادس، في مواده من (33–38)، ينصّ على دور مجلس الأمن في دعوة الدول إلى تنفيذ الوسائل السلمية لحلّ النزاعات الدولية من خلال المفاوضات، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية. وتتصف قرارات مجلس الأمن هنا بكونها غير إلزامية.
أما الفصل السابع، فينصّ على التنفيذ القسري لقرارات مجلس الأمن، ويتضمّن استخدام وسائل القوة لحلّ النزاعات التي تهدّد الأمن والسلم الدوليين. وأهمّ مواده (39–41–42)، وهي لبّ موضوع الفصل، إذ تُجيز استخدام أشكال القوة سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو الحصار أو الوسائل العسكرية. ويعمل مجلس الأمن، بغية تنفيذ قراراته، على تطبيق تدابير وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات والعلاقات الدبلوماسية جزئياً أو كلياً، وفي حالة عدم نجاعة هذه التدابير، يلجأ إلى دعوة القوات العسكرية التابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والموضوعة تحت تصرّفها، للعمل على إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، بموجب المادتين (41، 42). كما يمكن لدولٍ غير أعضاء أن تساهم في تنفيذ قرارات المجلس وفق الإجراءات التي نصّت عليها المادتان (43، 44).
المشروع الأميركي... ما وراء العناوين
منذ السابع من أكتوبر 2023، تعمل واشنطن على تسويق فكرة أن غزة بعد الحرب تحتاج إلى "مرحلة استقرار"، لا إلى انسحابٍ فوري، ولا إلى عودةٍ كاملةٍ للسلطة الوطنية الفلسطينية. والمشروع الذي صاغته وزارة الخارجية الأميركية، وأعيد صياغته على طاولة مجلس الأمن، إذ يقترح نشر قواتٍ متعددة الجنسيات بقيادة دولٍ "محايدة" – مثل كندا والدنمارك، وربما دولٍ عربية – لإدارة الشأنين الأمني والإغاثي داخل غزة.
لكن، خلف هذا الطرح الإنساني الظاهري، يكمن جوهرٌ استراتيجيٌّ أعمق: تقليص الدور الفلسطيني في إدارة ما بعد العدوان، وتوفير مظلّةٍ قانونيةٍ لإسرائيل لتجنّب مسؤولية الاحتلال، وخلق واقعٍ سياسيٍّ جديد يجعل غزة منطقةً تحت إشرافٍ دوليٍّ غير مباشر. إنها، باختصار، وصايةٌ سياسيةٌ دوليةٌ بأدواتٍ أمنيةٍ واستثمارية.
المخاطر على الوعي والسيادة الفلسطينية
1. المسّ بالسيادة الوطنية: أي وجودٍ عسكريٍّ أجنبي، مهما كان علمه أزرقاً أو براقاً، هو خصمٌ من مفهوم السيادة إذا لم ينبثق من إرادةٍ فلسطينيةٍ خالصة مدعوم بقرار المنتظم الدولي.
2. التطبيع مع السيطرة غير المباشرة: قد تتحوّل القوة إلى "غطاءٍ قانوني" لإدامة هيمنة الاحتلال، بحيث يبقى قطاع غزة "هادئاً ومفتوحاً"، ولكن دون حريةٍ حقيقية أو سيادةٍ فعلية.
3. تحويل المعاناة إلى إدارة: الخطر الأكبر أن تصبح أزمة غزة مجرّد ملفٍ إداريٍّ تتناوله اللجان الدولية بالميزانيات لا بالعدالة، فتغيب الجذور السياسية للصراع.
4. التأثير على الهوية الوطنية: جيل ما بعد الحرب قد ينشأ على واقعٍ جديد يرى في "القوات الدولية" سلطةً فوق وطنية، وهو ما يهدّد الوعي الجمعي الفلسطيني ويضعف روح المقاومة المدنية والسياسية.
أين يقف الفلسطينيون من هذه المعادلة؟
يقف الشعب الفلسطيني اليوم أمام مفترقٍ دقيقٍ بين أمنٍ مفروضٍ وسيادةٍ منتزعة. فإن أُنشئت هذه القوة بموافقةٍ فلسطينيةٍ صريحة، وتحت إشرافٍ أمميٍّ حياديٍّ حقيقي، وبهدف تمكين الفلسطينيين لا تقييدهم، فقد تكون خطوةً مرحليةً ضروريةً نحو إعادة البناء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. لكن، إن جاءت مفروضةً من الخارج، تقودها إرادةٌ سياسيةٌ لا ترى في غزة سوى "منطقةٍ أمنيةٍ واستثمارية"، فإنها ستكون حكماً نظامَ وصايةٍ جديداً بوجهٍ ناعمٍ ويدٍ حديدية.
خاتمة: ما بين الأمن والكرامة
القضية ليست في لون العلم الذي سيرفرف فوق غزة الفلسطينية، بل بمن يملك القرار على الأرض. قد يأتي الهدوء والسلام مؤقتاً مع هذه القوة، وقد يعود الأمن إلى بعض الشوارع، لكن الكرامة الوطنية لا تُدار عبر بندقيةٍ أممية، بل تُبنى بإرادة الشعوب. فالولايات المتحدة، التي تسوّق اليوم لفكرة "الاستقرار"، تبحث في الحقيقة عن أمن للاحتلال من جهة، وعن الاستثمار في مشاريع ضخمة وفق خطة كوشنر-ويتكوف من جهةٍ أخرى، عبر استغلال مقدّرات الشعب الفلسطيني في القطاع (الغاز، البترول، والأرض). وبالطبع، لا تبحث عن سلامٍ لشعبنا الفلسطيني، علماً بأن الضفة الغربية بعيدةٌ كلّ البعد عن مختلف المشاريع الأميركية (ترامب، بلير، كوشنر- ويتكوف) وهذا يعتبر تكريس فصل جغرافي بين غزة والضفة بما فيها القدس. لذلك، فإن الفلسطينيين أمام اختبارٍ تاريخيٍّ جديد: هل يقبلون بسلامٍ بلا سيادة؟ أم يصنعون استقرارهم بكرامةٍ وسيادةٍ من داخلهم؟
جمال أبوغليون
[email protected]
6/11/2025