الاعتراف الأوروبي بـ"دولة فلسطين": بين الفارق الدلالي والقانوني وتجاوزات وعد بلفور والقرار 194
بي دي ان |
30 يوليو 2025 الساعة 08:40م
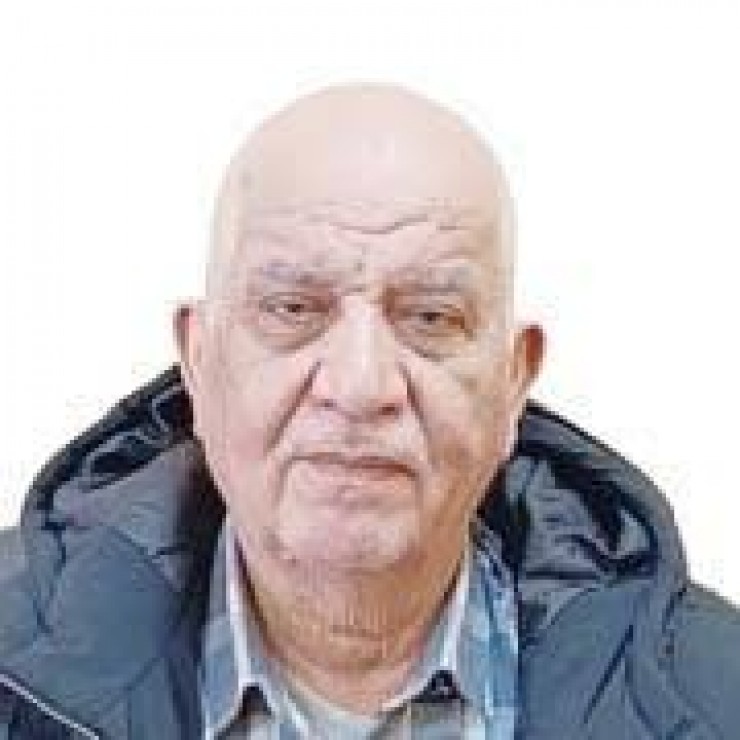 الكاتب
الكاتب
ضمن سلسلة التحليلات السياسية
لم يعد من الممكن فصل التفاعلات السياسية الدولية عن التطورات الميدانية والحقوقية في القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد الاعترافات الأوروبية بـ"دولة فلسطين". غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في هذا السياق: هل نحن إزاء اعتراف حقيقي بدولة فلسطينية مكتملة السيادة؟ أم مجرد اعتراف رمزي يحمل دلالات سياسية لا ترتقي إلى مستوى الإلزام القانوني؟ وما موقع هذا الاعتراف من التاريخ القانوني والسياسي الذي بدأ مع وعد بلفور ولم ينتهِ بعد بقرار التقسيم والقرار 194؟
أولاً: الفرق بين "دولة" و"الدولة": دلالة قانونية لا يجوز إغفالها
من الناحية القانونية، لا تُعتبر "الدولة" دولة إلا إذا استوفت المعايير الأربعة المعروفة في القانون الدولي، كما نصت عليها اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933:
1. وجود إقليم محدد.
2. وجود شعب دائم.
3. وجود حكومة فعالة.
4. القدرة على الدخول في علاقات دولية.
وبينما تتوفر بعض هذه العناصر في الحالة الفلسطينية، إلا أن غياب السيادة الكاملة، واستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وعدم السيطرة على الموارد والمعابر والحدود، كلها تُضعف من تحقق هذه الشروط فعلياً.
بالمقابل، فإن استخدام معظم الدول الأوروبية لعبارة "الاعتراف بدولة فلسطين" دون "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، يُظهر تحفّظًا دبلوماسيًا مدروسًا، يقف في منتصف الطريق بين الحق الفلسطيني والتزامات تلك الدول السياسية تجاه إسرائيل.
ثانياً: الاعتراف الأوروبي... خطوة سياسية أم إعلان قانوني؟
جاءت الاعترافات الأوروبية – لا سيما من إيرلندا وإسبانيا والنرويج – على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. غير أن هذا الاعتراف لم يترافق مع خطوات سيادية كالاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، أو فرض عقوبات على الاحتلال، أو دعم حق تقرير المصير فعلياً.
من الناحية القانونية، فإن هذه الاعترافات تُعد خطوات سياسية غير مُلزِمة قانونًا، ولا تنتج عنها آثار قانونية على إسرائيل كدولة محتلة. بل إن بعضها جاء مقرونًا بعبارات تؤكد أن هذا الاعتراف لا يعني تغييرًا في العلاقات مع إسرائيل، ما يضعف القيمة القانونية للاعتراف ويفرغه من مضمونه.
ثالثاً: هل يشكل الاعتراف الأوروبي تجاوزًا لوعد بلفور؟
وعد بلفور لعام 1917، الذي قدّمته بريطانيا على شكل رسالة إلى اللورد روتشيلد، نصّ على دعم "إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين"، دون أدنى اعتبار للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، بل وصفهم بـ"الجماعات غير اليهودية". هذا الوعد شكّل الأساس القانوني والسياسي للنكبة، وما تلاها من احتلال وتشريد.
إن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية – ولو رمزياً – يمكن اعتباره تراجعًا أخلاقيًا وسياسيًا جزئيًا عن وعد بلفور، خاصة أن بعض هذه الدول كانت شريكة تاريخية في فرض المشروع الصهيوني. لكن هذا التراجع لا يرقى إلى مستوى الاعتراف بالمسؤولية التاريخية أو تصحيح الظلم القانوني الناجم عن ذلك الوعد، ولا يقرّ – حتى الآن – بأن وعد بلفور نفسه مخالف للقانون الدولي، لأنه منح أرضًا لا يملكها لمن لا يستحقها، متجاهلاً الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
رابعاً: القرار 194 وحق العودة... الغائب الأكبر
ينص القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، في فقرته 11، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ومع ذلك، فإن الاعتراف الأوروبي لم يربط هذا الاعتراف بأية إشارة لحق العودة، بل تجاهله كليًا، ما يثير القلق من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين قد يُوظف لاحقًا لتصفية حق العودة عبر القبول بكيان فلسطيني "مؤقت" أو "ناقص السيادة" على جزء من الأرض، مقابل تنازلات جوهرية عن القضايا المفصلية.
وهنا تكمن الخطورة القانونية والسياسية: الاعتراف بـ"دولة" فلسطينية منقوصة السيادة قد يُستعمل كغطاء دولي لتثبيت واقع الاحتلال، وتصفية الحقوق التاريخية للفلسطينيين، في ظل غياب التزامات دولية صريحة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 194.
خامساً: قراءة تحليلية في المواقف الأوروبية
يبدو واضحًا أن الاعترافات الأوروبية تأتي في سياق متغيرات دولية وضغوط شعبية وأخلاقية، لكنها ما زالت محكومة بسقف التحالف الغربي مع إسرائيل، والتزامات أمنية وعسكرية تحول دون اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الاحتلال.
وحتى الآن، لم تتجرأ أي دولة أوروبية على اتخاذ خطوات قانونية ملزمة، كالمطالبة بإحالة جرائم الحرب في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، أو دعم مبادرات تضمن إنهاء الاحتلال فعليًا.
بالتالي، فإن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يبقى محصورًا في الإطار السياسي الرمزي، دون أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسار الصراع أو في ميزان العدالة الدولية.
خاتمة: الدولة لا تكون باعتراف لفظي بل بتطبيق القانون
إن الاعتراف بـ"دولة فلسطين" لا يكتمل إلا إذا ارتبط بإجراءات قانونية دولية تُنهي الاحتلال، وتضمن عودة اللاجئين، وتحقيق العدالة، وفرض المساءلة على إسرائيل كدولة احتلال تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وحتى يتحقق ذلك، فإن مسؤولية الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لا تقف عند حدود الاعتراف اللفظي، بل تتطلب نضالاً قانونيًا ودبلوماسيًا متواصلاً لتثبيت الحق الفلسطيني بكل أبعاده، التاريخية، والسياسية، والقانونية.
لم يعد من الممكن فصل التفاعلات السياسية الدولية عن التطورات الميدانية والحقوقية في القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد الاعترافات الأوروبية بـ"دولة فلسطين". غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه في هذا السياق: هل نحن إزاء اعتراف حقيقي بدولة فلسطينية مكتملة السيادة؟ أم مجرد اعتراف رمزي يحمل دلالات سياسية لا ترتقي إلى مستوى الإلزام القانوني؟ وما موقع هذا الاعتراف من التاريخ القانوني والسياسي الذي بدأ مع وعد بلفور ولم ينتهِ بعد بقرار التقسيم والقرار 194؟
أولاً: الفرق بين "دولة" و"الدولة": دلالة قانونية لا يجوز إغفالها
من الناحية القانونية، لا تُعتبر "الدولة" دولة إلا إذا استوفت المعايير الأربعة المعروفة في القانون الدولي، كما نصت عليها اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933:
1. وجود إقليم محدد.
2. وجود شعب دائم.
3. وجود حكومة فعالة.
4. القدرة على الدخول في علاقات دولية.
وبينما تتوفر بعض هذه العناصر في الحالة الفلسطينية، إلا أن غياب السيادة الكاملة، واستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وعدم السيطرة على الموارد والمعابر والحدود، كلها تُضعف من تحقق هذه الشروط فعلياً.
بالمقابل، فإن استخدام معظم الدول الأوروبية لعبارة "الاعتراف بدولة فلسطين" دون "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، يُظهر تحفّظًا دبلوماسيًا مدروسًا، يقف في منتصف الطريق بين الحق الفلسطيني والتزامات تلك الدول السياسية تجاه إسرائيل.
ثانياً: الاعتراف الأوروبي... خطوة سياسية أم إعلان قانوني؟
جاءت الاعترافات الأوروبية – لا سيما من إيرلندا وإسبانيا والنرويج – على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. غير أن هذا الاعتراف لم يترافق مع خطوات سيادية كالاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، أو فرض عقوبات على الاحتلال، أو دعم حق تقرير المصير فعلياً.
من الناحية القانونية، فإن هذه الاعترافات تُعد خطوات سياسية غير مُلزِمة قانونًا، ولا تنتج عنها آثار قانونية على إسرائيل كدولة محتلة. بل إن بعضها جاء مقرونًا بعبارات تؤكد أن هذا الاعتراف لا يعني تغييرًا في العلاقات مع إسرائيل، ما يضعف القيمة القانونية للاعتراف ويفرغه من مضمونه.
ثالثاً: هل يشكل الاعتراف الأوروبي تجاوزًا لوعد بلفور؟
وعد بلفور لعام 1917، الذي قدّمته بريطانيا على شكل رسالة إلى اللورد روتشيلد، نصّ على دعم "إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين"، دون أدنى اعتبار للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، بل وصفهم بـ"الجماعات غير اليهودية". هذا الوعد شكّل الأساس القانوني والسياسي للنكبة، وما تلاها من احتلال وتشريد.
إن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطينية – ولو رمزياً – يمكن اعتباره تراجعًا أخلاقيًا وسياسيًا جزئيًا عن وعد بلفور، خاصة أن بعض هذه الدول كانت شريكة تاريخية في فرض المشروع الصهيوني. لكن هذا التراجع لا يرقى إلى مستوى الاعتراف بالمسؤولية التاريخية أو تصحيح الظلم القانوني الناجم عن ذلك الوعد، ولا يقرّ – حتى الآن – بأن وعد بلفور نفسه مخالف للقانون الدولي، لأنه منح أرضًا لا يملكها لمن لا يستحقها، متجاهلاً الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
رابعاً: القرار 194 وحق العودة... الغائب الأكبر
ينص القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، في فقرته 11، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ومع ذلك، فإن الاعتراف الأوروبي لم يربط هذا الاعتراف بأية إشارة لحق العودة، بل تجاهله كليًا، ما يثير القلق من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين قد يُوظف لاحقًا لتصفية حق العودة عبر القبول بكيان فلسطيني "مؤقت" أو "ناقص السيادة" على جزء من الأرض، مقابل تنازلات جوهرية عن القضايا المفصلية.
وهنا تكمن الخطورة القانونية والسياسية: الاعتراف بـ"دولة" فلسطينية منقوصة السيادة قد يُستعمل كغطاء دولي لتثبيت واقع الاحتلال، وتصفية الحقوق التاريخية للفلسطينيين، في ظل غياب التزامات دولية صريحة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 194.
خامساً: قراءة تحليلية في المواقف الأوروبية
يبدو واضحًا أن الاعترافات الأوروبية تأتي في سياق متغيرات دولية وضغوط شعبية وأخلاقية، لكنها ما زالت محكومة بسقف التحالف الغربي مع إسرائيل، والتزامات أمنية وعسكرية تحول دون اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الاحتلال.
وحتى الآن، لم تتجرأ أي دولة أوروبية على اتخاذ خطوات قانونية ملزمة، كالمطالبة بإحالة جرائم الحرب في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، أو دعم مبادرات تضمن إنهاء الاحتلال فعليًا.
بالتالي، فإن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يبقى محصورًا في الإطار السياسي الرمزي، دون أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسار الصراع أو في ميزان العدالة الدولية.
خاتمة: الدولة لا تكون باعتراف لفظي بل بتطبيق القانون
إن الاعتراف بـ"دولة فلسطين" لا يكتمل إلا إذا ارتبط بإجراءات قانونية دولية تُنهي الاحتلال، وتضمن عودة اللاجئين، وتحقيق العدالة، وفرض المساءلة على إسرائيل كدولة احتلال تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وحتى يتحقق ذلك، فإن مسؤولية الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لا تقف عند حدود الاعتراف اللفظي، بل تتطلب نضالاً قانونيًا ودبلوماسيًا متواصلاً لتثبيت الحق الفلسطيني بكل أبعاده، التاريخية، والسياسية، والقانونية.













