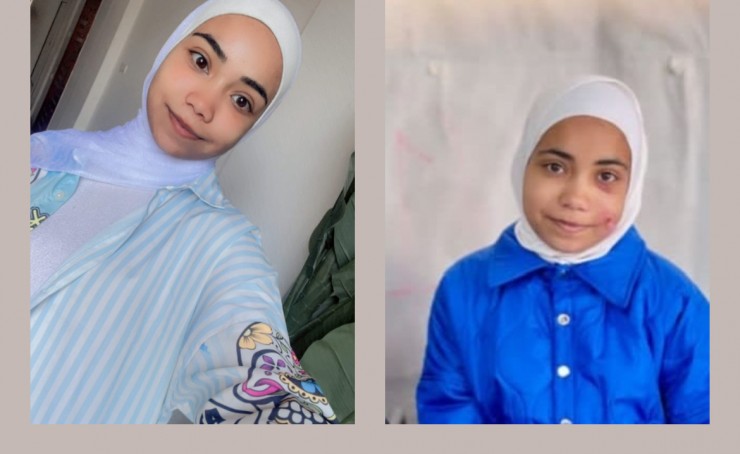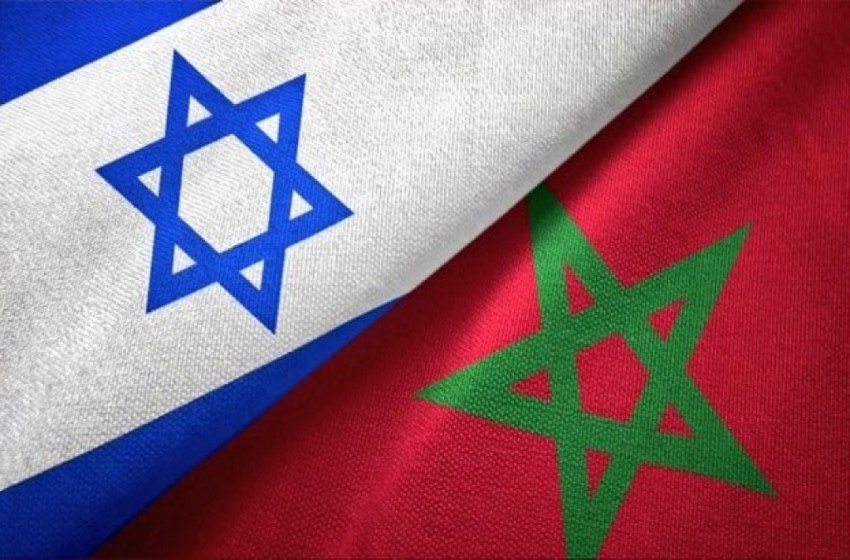صديقي الروائي (قتيل غزّة، الذي عاد!)
بي دي ان |
07 مارس 2024 الساعة
08:55م
 الكاتب
الكاتب
المتوكل طه
أعرفُ الشخصَ القتيلَ؛ وكيف عاشَ..
وكيف ماتْ!
يشربُ الكابوسَ حتى يثملَ العصفورُ، من دمهِ،
ويصحو، كي يرى أحفادَه يمضون في التابوتِ
للحربِ الأخيرةِ، ثم يكتبُ ما تيسَّرَ للرُّواةْ،
هلَّا صَبَرْتَ؟ سألتُهُ!
فبكى،
وخبّأ نَهْرَهُ في كُمِّهِ، ومضى إلى بحرِ الحريقِ،
ولم تزل نارٌ على قمصانِهِ،
ولهُ الجروحُ بلونِ ليلتِهِ،
ويلحفُ أن يبلَّ عُروقَهُ، لكنَّه المَصْلِيُّ
من ظمأ المُغنِّي في البَياتْ.
***
كنّا قُبيلَ الانفجارِ على بلاطِ القدس نلهثُ،
كي نرى أسماءَنا.
ولَكَم رأينا ألفَ سيفٍ خلفَ أبوابِ الأزقَّةِ،
ثمّ أعدَدنا الطريقَ لنحملَ السورَ الأسيرَ ،
ونجمع الليمونَ من بحرٍ لنا..
نمشي إلى الآباءِ؛
مَنْ عَصَروا دَمَ الحَنُّونِ في قلبِ النَّواةْ.
بكى..
تَذَكَّرَ عسقلانَ! ولم يعُدْ منصورُ..
لم تَمْضِ النوارسُ للشّمالِ أو الثغور..
وَتَري قديمٌ يا صديقي!
لم يَعُدْ زمني بياضاً سُكَّرياً؟
والغزالةُ لم تصل رملَ المرافئ!
والنَواتي دون نجمتهِ!
وهذا الظِلُّ ظِلُّ الموتِ يهجسُ بالمَواتْ!
***
لم أبلُغِ الشهرينِ من عُمري!
وحكمةُ جدَّتي ألّا نبارحَ دارَنا ..
لكنّها الأعراضُ والساطورُ والحدسُ المخيفُ ..
وربما كادوا ،هنا، يرموا الصغيرَ،
ولو مشينا بعد غزةَ لم أكنْ...
جفَّ الحليبُ، وصار سُمّاً في الُّلهاةْ.
لكنَّني، من بعدِ ما نَفرَ الحصانُ،
وشاعَ زيتُ الروحِ في القنديلِ،
قد أكملتُ أولَّ قصةٍ، ودفعتُها لِمُعَلِّمي،
فأشار لي أنْ أجمعَ البحرَ الكبيرَ، بقبضتي،
ليكونَ مثلَ الوحشِ ،في وَجْهِ الطُّغاةْ.
وأنا رسولٌ لم يَضِلّ،
ولم أكن عِطراً لجثَّةِ لاجئٍ،
حصَّنتُ صدري من حجارةِ هاجرٍ،
وزرعتُ أغصاني، لترقصَ في العواصفِ،
دلَّني طيري على حُلمي،
لأولَدَ من دماءِ عشيرتي القتلى،
لنخرجَ من سُباتٍ أو شَتاتْ.
وَلَكَمْ نظرتُ فلم أجد سيلاً يُرَنِّقُ أضلُعي،
فشربتُ شرياني،
وأسوارُ العواصِمِ أغلقت أبوابَها،
ففتحتُ وجهي للرياحِ،
وكان أعمامي، بِذُلٍّ، يركعون لقاتلي،
فشحذتُ عَظمي بالرماحِ،
وعانقوه وسلَّموه مقابضَ الأقصى،
وأهدوه السواحلَ والفُراتْ.
خريطتي تمتدُّ من قلبِ الأسيرِ إلى حدائقِ نجمةٍ،
في غابة الجرحى.. إلى قَبْوِ السِّياطِ،
ومن أناشيدِ الحقول، إلى سماءِ الخارجين
من القيودِ،
ومن نداء الأُمَّهاتِ الثاكلاتِ،
وراءَ أسوارِ البُغاةِ،
ومن ركامِ مُخيَّم الشهداء، ليلاً،
للحقائبِ، ترسم الدنيا نهاراً في فضاءِ الأغنيات..
***
من أربعينَ ونحن نكتبُ..
هل مَحونا نُدبةَ الأفعى؟
وهل عادَ الشهيدُ من القصيدِ؟
وهل أعاد العيدُ ألعابَ البناتْ!
فكَّرتُ أن أمشي بعيداً، ذات حربٍ،
كانت امرأتي تودِّعُ صورتين على الجدارِ،
وصرتُ وحدي،
فانتبذتُ ،لكي أجوحَ على السنين،
-مضت بلا معنىً-
وأدركتُ الحدودَ، وكِدْتُ أصعدُ كالمهاجرِ..
غيرَ أنّي قد تذكَّرتُ الرّوايةَ!
مَنْ سيُكمِلُها إذا راح المسافرُ،
مَنْ سيملأُ بعضَ أوراقٍ هنالك، وحدَها، قُرْبَ الدَّواةْ؟
***
أنا لم أَنَمْ سبعين عاماً..
منذُ أن أخذوا الطفولةَ من يديَّ ومن مرايانا..
وأذكرُ، مرّةً، أنّا ذهبنا كي نُعابثَ موجةً
لكنها سحبت ،إلى الأعماقِ، أجمَلنا،
فعُدنا، والطريقُ إلى الشواطئِ قد تطولُ..
كما تَطولُ الذكرياتْ!
وعلى ضفافِ الشاطئِ المحزونِ صيَّادٌ
يغنِّي للشِباكِ،
وحين زاد نحيبُ أترابي.. بكى،
وتحوَّل الموّالُ من رقصٍ بسيطٍ،
في المساءِ، إلى نُواحٍ في الصلاة..
وعندها أدركتُ حين سمعتُه،
في يومِ عُرْسٍ كان لابنتِه.. وحين أتوا وقالوا: قُمْ لترقصَ،
قال: لا!
قدماي إنْ رقصتْ ستَسقي أرضهَا وَجعاً
وتضربُ قلبَها بالنائِحاتْ.
ولذا بكى الغرباءُ،
طوبى للغريبِ..
أكلَّما ابتهجَ السُنونو، يومَ عيدٍ،
هَبَّ حُزنٌ في بيوتِ القُبّراتْ!
***
وعشقتُ..
كنتُ أفتّشُ الطرقاتِ عن منديلِها،
أو ربَّما تَركَتْ حروفاً في الجذوعِ،
وبِتُّ أبحثُ عن غزالٍ لم يعُدْ!
..وعرفتُ أنَّي زهرةُ الألمِ المُمِضِّ..
وهل أنا، والزعفرانُ يدقُّ قلبي، غيرُ نهرٍ
قد تدفَّقَ في شرايين السُّراةْ!
جسدي عدوِّي قد تخفَّى في الرسائلِ،
وهي في بلُّورةٍ تطفو على الأمواجِ..
أكتبُ، والحريقُ يدبُّ في أشجارهِ..
لا ضوءَ غيرُ النارِ،
لا مرثاةَ إلا للقتيلِ،
ولا قتيلَ سوى غريبِ الدارِ في هذي الحياةْ.
أنا الغريبُ سأستعيدُ اسمي نبيّاً،
حين يرجعُ آخرُ الأحفادِ للبلدِ الذي
حملَ البِشارةَ للرُّعاةْ.
فامشوا ورائي بالزنابقِ،
واسمعوا الصَنّاجةَ الماشين في شَهدِ المغيبِ،
تذكّروا أنّا ظللنا حولَ مَوْقَدِنا،
ولم نرحلْ كما شاءَ الغروبُ،
وأنني ما زلتُ أضحكُ
كلَّما ابتسمَ الرضيعُ،
وقد يناغيني.. يُتأتئُ باسمِ جدَّتهِ أو اسمي،
مثلَ ضوءٍ قد تفشّى في شِفاهِ الّلعثَماتْ.
***
لا شيء يشفعُ يا صديقي!
نحنُ كَسْرٌ واضحٌ؛ أعني بأنا قد تركنا صورةَ الأجدادِ
تبكي وحدَها،
-بقيَت هناك-
تعاودُ الأسماءَ والأصداءَ، تنظرُ
لا ترى أحداً سوى العتماتِ،
والصمتِ الذليلِ،
تصيحُ ملءَ الليلِ..
هل سمعوا النداءَ؟ إذاً أجِبْني!
لا تعاند مثلما تُنهي الحوارَ..
وتتركُ المرآةَ ساهمةً على صمتِ العُراةْ.
ولا تكن أفعى الحكايةِ، واتركِ التفاحَ،
وانظرْ للبتولِ، وقلْ لها؛ لن تُخطِئي!
لا شيءَ يدعو للخروجِ من الجنانِ سوى الخطايا..
والخطايا خلفَنا ثوبٌ خلعنا لونَه العاري،
وما قد فاتَ.. فاتْ!
***
عانقتُه من بعد أعوامٍ،
فعَبّأني نزيفٌ من يديه!
مآذنٌ تبكي على جَرَسِ الرجوعِ،
فلا لقاءَ
ولا رجاءَ
ولا عزاءَ، بأرضِ غزّةَ، لِلُّغاتْ.
-لقد نسوا أنّا جميعاً تحت سقفٍ واحدٍ.. للطائراتْ-
وكيف لي ألّا أجيءَ لبيتِهِ!
مَنْ سوف يأخُذُني لنجلسَ،تحتَ داليةٍ، بقربِ البحرِ؟
كيف الشايُ سوفَ يكونُ، أو طعمُ الكلامِ؟
..أنا أحبُّكَ يا صديقي!
لم أفكرْ، لحظةً، أنّي سأرثي وردةً لِسياجِها.
هل مُتَّ حقاً؟
ربَّما هذا مجازٌ..
ربَّما.. ستغيب تحت الرّدم،
أو ستكون في الأخدودِ مع ألفٍ، وقد
تتوقّف الحربُ اللعينةُ، كي أراك!
فهل أراك ؟
تقول: إنك لن تعودَ!..
سمعتُها من دَفْقةِ النيرانِ ، عن بُعدٍ .. كأنكَ
صوتُها الدّامي ..
يُؤَوِّبُ في الجهات.
بي دي ان |
07 مارس 2024 الساعة 08:55م
 الكاتب
الكاتب
المتوكل طه
وكيف ماتْ!
يشربُ الكابوسَ حتى يثملَ العصفورُ، من دمهِ،
ويصحو، كي يرى أحفادَه يمضون في التابوتِ
للحربِ الأخيرةِ، ثم يكتبُ ما تيسَّرَ للرُّواةْ،
هلَّا صَبَرْتَ؟ سألتُهُ!
فبكى،
وخبّأ نَهْرَهُ في كُمِّهِ، ومضى إلى بحرِ الحريقِ،
ولم تزل نارٌ على قمصانِهِ،
ولهُ الجروحُ بلونِ ليلتِهِ،
ويلحفُ أن يبلَّ عُروقَهُ، لكنَّه المَصْلِيُّ
من ظمأ المُغنِّي في البَياتْ.
***
كنّا قُبيلَ الانفجارِ على بلاطِ القدس نلهثُ،
كي نرى أسماءَنا.
ولَكَم رأينا ألفَ سيفٍ خلفَ أبوابِ الأزقَّةِ،
ثمّ أعدَدنا الطريقَ لنحملَ السورَ الأسيرَ ،
ونجمع الليمونَ من بحرٍ لنا..
نمشي إلى الآباءِ؛
مَنْ عَصَروا دَمَ الحَنُّونِ في قلبِ النَّواةْ.
بكى..
تَذَكَّرَ عسقلانَ! ولم يعُدْ منصورُ..
لم تَمْضِ النوارسُ للشّمالِ أو الثغور..
وَتَري قديمٌ يا صديقي!
لم يَعُدْ زمني بياضاً سُكَّرياً؟
والغزالةُ لم تصل رملَ المرافئ!
والنَواتي دون نجمتهِ!
وهذا الظِلُّ ظِلُّ الموتِ يهجسُ بالمَواتْ!
***
لم أبلُغِ الشهرينِ من عُمري!
وحكمةُ جدَّتي ألّا نبارحَ دارَنا ..
لكنّها الأعراضُ والساطورُ والحدسُ المخيفُ ..
وربما كادوا ،هنا، يرموا الصغيرَ،
ولو مشينا بعد غزةَ لم أكنْ...
جفَّ الحليبُ، وصار سُمّاً في الُّلهاةْ.
لكنَّني، من بعدِ ما نَفرَ الحصانُ،
وشاعَ زيتُ الروحِ في القنديلِ،
قد أكملتُ أولَّ قصةٍ، ودفعتُها لِمُعَلِّمي،
فأشار لي أنْ أجمعَ البحرَ الكبيرَ، بقبضتي،
ليكونَ مثلَ الوحشِ ،في وَجْهِ الطُّغاةْ.
وأنا رسولٌ لم يَضِلّ،
ولم أكن عِطراً لجثَّةِ لاجئٍ،
حصَّنتُ صدري من حجارةِ هاجرٍ،
وزرعتُ أغصاني، لترقصَ في العواصفِ،
دلَّني طيري على حُلمي،
لأولَدَ من دماءِ عشيرتي القتلى،
لنخرجَ من سُباتٍ أو شَتاتْ.
وَلَكَمْ نظرتُ فلم أجد سيلاً يُرَنِّقُ أضلُعي،
فشربتُ شرياني،
وأسوارُ العواصِمِ أغلقت أبوابَها،
ففتحتُ وجهي للرياحِ،
وكان أعمامي، بِذُلٍّ، يركعون لقاتلي،
فشحذتُ عَظمي بالرماحِ،
وعانقوه وسلَّموه مقابضَ الأقصى،
وأهدوه السواحلَ والفُراتْ.
خريطتي تمتدُّ من قلبِ الأسيرِ إلى حدائقِ نجمةٍ،
في غابة الجرحى.. إلى قَبْوِ السِّياطِ،
ومن أناشيدِ الحقول، إلى سماءِ الخارجين
من القيودِ،
ومن نداء الأُمَّهاتِ الثاكلاتِ،
وراءَ أسوارِ البُغاةِ،
ومن ركامِ مُخيَّم الشهداء، ليلاً،
للحقائبِ، ترسم الدنيا نهاراً في فضاءِ الأغنيات..
***
من أربعينَ ونحن نكتبُ..
هل مَحونا نُدبةَ الأفعى؟
وهل عادَ الشهيدُ من القصيدِ؟
وهل أعاد العيدُ ألعابَ البناتْ!
فكَّرتُ أن أمشي بعيداً، ذات حربٍ،
كانت امرأتي تودِّعُ صورتين على الجدارِ،
وصرتُ وحدي،
فانتبذتُ ،لكي أجوحَ على السنين،
-مضت بلا معنىً-
وأدركتُ الحدودَ، وكِدْتُ أصعدُ كالمهاجرِ..
غيرَ أنّي قد تذكَّرتُ الرّوايةَ!
مَنْ سيُكمِلُها إذا راح المسافرُ،
مَنْ سيملأُ بعضَ أوراقٍ هنالك، وحدَها، قُرْبَ الدَّواةْ؟
***
أنا لم أَنَمْ سبعين عاماً..
منذُ أن أخذوا الطفولةَ من يديَّ ومن مرايانا..
وأذكرُ، مرّةً، أنّا ذهبنا كي نُعابثَ موجةً
لكنها سحبت ،إلى الأعماقِ، أجمَلنا،
فعُدنا، والطريقُ إلى الشواطئِ قد تطولُ..
كما تَطولُ الذكرياتْ!
وعلى ضفافِ الشاطئِ المحزونِ صيَّادٌ
يغنِّي للشِباكِ،
وحين زاد نحيبُ أترابي.. بكى،
وتحوَّل الموّالُ من رقصٍ بسيطٍ،
في المساءِ، إلى نُواحٍ في الصلاة..
وعندها أدركتُ حين سمعتُه،
في يومِ عُرْسٍ كان لابنتِه.. وحين أتوا وقالوا: قُمْ لترقصَ،
قال: لا!
قدماي إنْ رقصتْ ستَسقي أرضهَا وَجعاً
وتضربُ قلبَها بالنائِحاتْ.
ولذا بكى الغرباءُ،
طوبى للغريبِ..
أكلَّما ابتهجَ السُنونو، يومَ عيدٍ،
هَبَّ حُزنٌ في بيوتِ القُبّراتْ!
***
وعشقتُ..
كنتُ أفتّشُ الطرقاتِ عن منديلِها،
أو ربَّما تَركَتْ حروفاً في الجذوعِ،
وبِتُّ أبحثُ عن غزالٍ لم يعُدْ!
..وعرفتُ أنَّي زهرةُ الألمِ المُمِضِّ..
وهل أنا، والزعفرانُ يدقُّ قلبي، غيرُ نهرٍ
قد تدفَّقَ في شرايين السُّراةْ!
جسدي عدوِّي قد تخفَّى في الرسائلِ،
وهي في بلُّورةٍ تطفو على الأمواجِ..
أكتبُ، والحريقُ يدبُّ في أشجارهِ..
لا ضوءَ غيرُ النارِ،
لا مرثاةَ إلا للقتيلِ،
ولا قتيلَ سوى غريبِ الدارِ في هذي الحياةْ.
أنا الغريبُ سأستعيدُ اسمي نبيّاً،
حين يرجعُ آخرُ الأحفادِ للبلدِ الذي
حملَ البِشارةَ للرُّعاةْ.
فامشوا ورائي بالزنابقِ،
واسمعوا الصَنّاجةَ الماشين في شَهدِ المغيبِ،
تذكّروا أنّا ظللنا حولَ مَوْقَدِنا،
ولم نرحلْ كما شاءَ الغروبُ،
وأنني ما زلتُ أضحكُ
كلَّما ابتسمَ الرضيعُ،
وقد يناغيني.. يُتأتئُ باسمِ جدَّتهِ أو اسمي،
مثلَ ضوءٍ قد تفشّى في شِفاهِ الّلعثَماتْ.
***
لا شيء يشفعُ يا صديقي!
نحنُ كَسْرٌ واضحٌ؛ أعني بأنا قد تركنا صورةَ الأجدادِ
تبكي وحدَها،
-بقيَت هناك-
تعاودُ الأسماءَ والأصداءَ، تنظرُ
لا ترى أحداً سوى العتماتِ،
والصمتِ الذليلِ،
تصيحُ ملءَ الليلِ..
هل سمعوا النداءَ؟ إذاً أجِبْني!
لا تعاند مثلما تُنهي الحوارَ..
وتتركُ المرآةَ ساهمةً على صمتِ العُراةْ.
ولا تكن أفعى الحكايةِ، واتركِ التفاحَ،
وانظرْ للبتولِ، وقلْ لها؛ لن تُخطِئي!
لا شيءَ يدعو للخروجِ من الجنانِ سوى الخطايا..
والخطايا خلفَنا ثوبٌ خلعنا لونَه العاري،
وما قد فاتَ.. فاتْ!
***
عانقتُه من بعد أعوامٍ،
فعَبّأني نزيفٌ من يديه!
مآذنٌ تبكي على جَرَسِ الرجوعِ،
فلا لقاءَ
ولا رجاءَ
ولا عزاءَ، بأرضِ غزّةَ، لِلُّغاتْ.
-لقد نسوا أنّا جميعاً تحت سقفٍ واحدٍ.. للطائراتْ-
وكيف لي ألّا أجيءَ لبيتِهِ!
مَنْ سوف يأخُذُني لنجلسَ،تحتَ داليةٍ، بقربِ البحرِ؟
كيف الشايُ سوفَ يكونُ، أو طعمُ الكلامِ؟
..أنا أحبُّكَ يا صديقي!
لم أفكرْ، لحظةً، أنّي سأرثي وردةً لِسياجِها.
هل مُتَّ حقاً؟
ربَّما هذا مجازٌ..
ربَّما.. ستغيب تحت الرّدم،
أو ستكون في الأخدودِ مع ألفٍ، وقد
تتوقّف الحربُ اللعينةُ، كي أراك!
فهل أراك ؟
تقول: إنك لن تعودَ!..
سمعتُها من دَفْقةِ النيرانِ ، عن بُعدٍ .. كأنكَ
صوتُها الدّامي ..
يُؤَوِّبُ في الجهات.