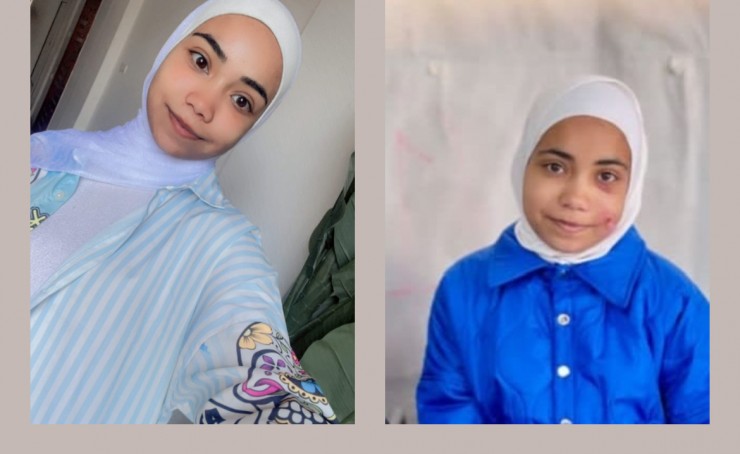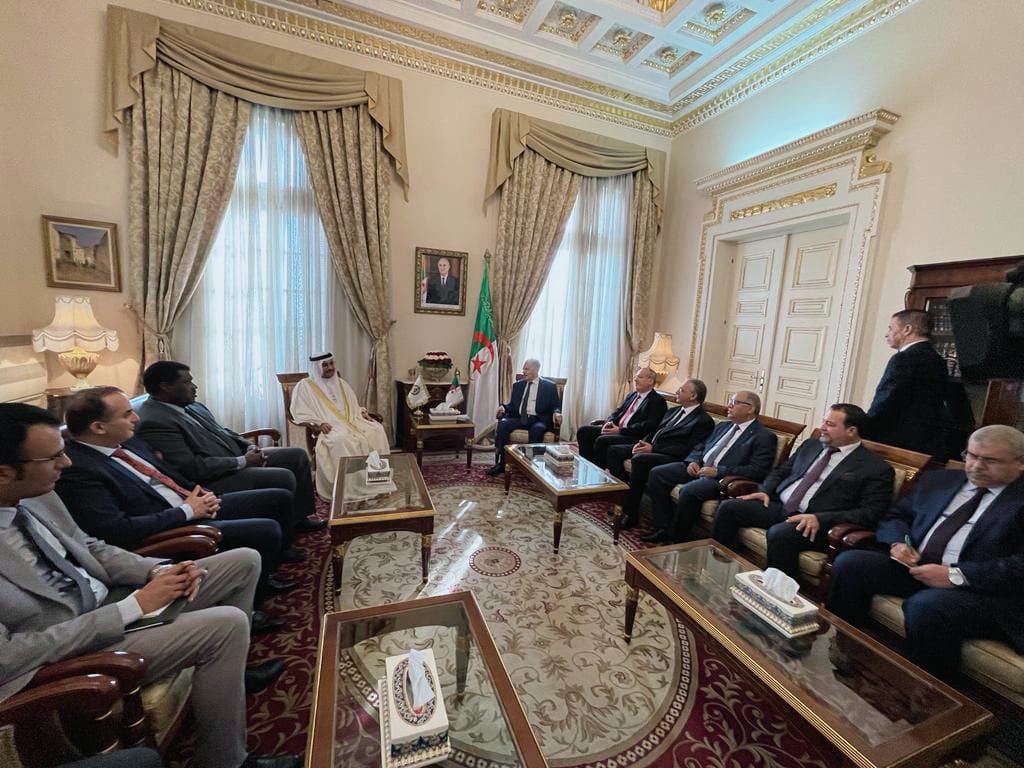الحفر في أرض الشعر أو حريق في أريحــا
بي دي ان |
09 نوفمبر 2020 الساعة
10:55م

جميل أبو صبيح
جبل عال من الصوان البني الداكن ، جبل أم شيخ جليل من الصخر الأزلي يفرد عباءته البنية الداكنة على واد شديد الخضرة ندعوه عين الديوك ، مسميات عديدة للشيخ الأزلي ، نعلم معنى بعضها وسرها ولا نعلم معنى بعضها الآخر ولا سره ، اسمه جبل قرنطل وأيضا جبل التجربة وأيضا جبل الدير، وربما له مسميات تالية غائبة عنّا .
إشاعة سرت بيننا ، نحن أطفال عين السلطان أن على هذا الجبل أراد الشيطان أن يخدع سيدنا عيسى لكنه لم يستطع ، تحاور معه ، طلب منه أن يلقي بنفسه إلى أسفل ويجرب الموت ، فإن بقي حياّ فسيؤمن به ، كان المسيح صائما ، لذلك سمي جبل التجربة . أما قرنطل فقد ظل غامضا مثله ، يثير فينا الرهبة والاحترام ، وكنا دائما نرى الشيطان واقفا على عمامة الجبل يحاور سيدنا عيسى ، فنلعنه .
أما الدير فهو البناء الأسطوري المبني في الهواء ، الملتصق بجدار سحيق في بطن قرنطل ، يثير فينا الدهشة والتساؤل والفخر الغامض ورغبة اكتشاف سرِّ الدير وغموض الجبل .
نحن أطفال عين السلطان عجيبون . لم نمَلّ روتين الجبل وهو يفرد علينا عصر كل يوم عباءة ظله حتى تنسحب أطرافها على امتداد أنظارنا إلى جبال البلقاء ، يأتينا المساء منه قبل أي مكان أخر على وجه الأرض ، فينسج لنا قبل هبوط العتمة عصرا يسقينا كأس الجمال وعذرية الأنثى ، زرافات يذرعن طريق العين ، على رؤوسهن الجرار وآنية الماء ، لم يكن يملأن آنيتهن ماء وإنما يملأن قلوبهن بعصافير الحب وقسدرة المساء ، وكنا نصطادهن ، بعيوننا وكلماتنا الراعفة ، ألوان مطرزة من سنابل الدوايمة وعجور وبئر السبع وما احتوى الشتات الفلسطيني ، ألوان شتى ، نوافيرَ نوافيرَ ، روح الفطرة وينابيع أقواس قزح تلمع حقولا يانعة على الطريق الممتدة من مقهى أبو سلامة إلى نبعة العين ، وحتى شارع المنتزهات .
نبعة العين التي تروي الظمآن ولا يعطش بعدها زمنا ، مياه أزلية تجري في جداول موغلة في القدم ، بنى على ضفتها أجدادنا حضارة الإنسان الأولى ، أول محراث يشق ترابا فيبذر حقلا ويعطي الإنسان لقمة خبزه ، أول إنسان يقدم لأخيه الإنسان حضارته ، كنا فخورين نحن أبناء عين السلطان بعين السلطان ، نمسك بأصابعنا العظام البالية في شوارعه ، نتأملها ثم نعيدها إلى التراب ، نشاكس بعثات الآثار المتعددة وبخاصة من الأجانب ، ونطلق على بعضها أسماء خاصة بنا ، كانت امرأة إنجليزية نلقبها " سعيدة باي باي " ، دائما تقول لنا " بَايْ باي " ، دون أن نعلم معنى كلامها ، لكنه يثير فينا الألفة وغموض المقابر التي تحفرها في ساحات بيوتنا وغرف نومنا ، فنرى داخلها فرساناً ممددين إلى جانب خيولهم وسيوفهم ودروعهم .
أثار هذا فينا غموض تلة عين السلطان ؛ نتسلل إليها كي نرى بقايا الجنود الكنعانيين على أسوار أريحا ، جنود قاتلوا حتى آخر مقاتل فيهم ، انتهت سهامه وانكسر سيفه وتكاثف حوله الغزاة ، لقد عرفنا قصة الزانية راحاب ويوشع الذي امتطى ظهور الزانيات في دخول مدن
الكنعانيين رأينا الماضي حاضراً جداًّ، منتصباً أمامنا، نحن أبناء عين السلطان، ولدنا في المخيم وترعرعنا تحت خيامه، وآباؤنا يجتمعون في مجالسه بعد أن يفرد قرنطل عتمته، يتحدثون عن تفاصيل حياتهم الضائعة في قرانا المسروقة ، كانت المجالس مدرستي الأولى والأهم، تعلمت فيها حكايا الدوايمة وأسرارها، ألفاظها ومصطلحاتها ويومياتها مع البدو، والجرأة النادرة في الليالي الحالكة ، على امتداد جنوب فلسطين وشرقي الأردن إلى ديار بني صخر، حياة تضج بالحياة تلك التي حفظتُ أدق تفاصيلها في مخيلتي، حتى صرت أعيشها ممزوجة بتفاصيل عين السلطان .
وفي عين السلطان مساء لا شبيه له، روائح الليمون على طرقات البساتين، وشقائق النعمان
منثورة على حواف الإسفلت ، والفتيان الفالتون من عتبات بيوتهم يطاردون فراشات المساء بفساتينها الملونة ، فساتين تشتعل على بوابات شوارع صبيحة والزهور والخديوي .
الخديوي، هذا الاسم الذي وفد إلينا من أحد حكام مصر في العهد التركي، كان عثمانيا يستطيب عين السلطان، فيقضي بها وقتا في طريقه إلى الأستانة. لم يُخلق شيء لم يمرّ بعين السلطان . قال الطبري في تاريخه أن مياه عين السلطان "أعذب ماء على وجه الأرض وأخفه على المعدة "، لذلك اغتالها اليهود عندما نهض يوشع جديدأ من قبره .
كل ذرة في عين السلطان شاهدة على إحدى تفاصيل التاريخ، غرفناها براحاتنا تأملناها بملئ أبصارنا وتعلمنا منها ماضينا وحاضرنا دون طباشير أو غرف مدرسية ، كانت التراب كما هو ، التراب المنثور بعصبية وعفوية في ساحات دواخلنا ، يثور فينا ولا نبحث عنه ، لقد كان تراب عين السلطان نحن ، ونحن أبناء أريحا أحفاد الأجداد ، نباتات الأساطير الأولى التي نفثت فينا عوالم الشعر والرواية والقصة والفن التشكيلي، وكل ما يحوكه مغزل النساج الأول. حائك الفطرة الأولى على مقاساتنا .
عين الديوك واد يتمدد بين يدي والده الشيخ الصخري ، مفعم بالبساتين والنخيل والموز ، لنا حكايات وحكايات بين أشجار موزه الكثيفة ، نترصد السارحات ، يرعين أغنامهن أو يلتقطن نباتات الخبيزة ، نملأ أيضا قمصاننا وبنطلوناتنا بأنواع مختلفة من نباتات فصل الربيع ونحن نكذب على أهلينا أننا ذاهبون للدراسة، لم يمنعنا شيء قط ، حتى أصحاب البساتين ونواطيرها لم يقدروا علينا ، لنا حكايات وحكايات مع ناطور دير قرنطل، جعلناه يوما يخلع بنطاله ثم يترجانا بعد أن هددناه ببندقيته، خلّصناها منه وقلنا له أنه لن يأخذها إلا إذا خلع بنطاله، خلعه ثم أفرغنا الخرطوش منها وأعطيناها له ، كان الدير سرّا غامضا فاعتليناه وشاكسنا نواطيره ونواطير عين الديوك ، وطالبات المدارس في رحلاتهن إلى عين الديوك ، لم يكن شيء أعذب من المشاكسة .
على ضفة عين الديوك الأخرى سلسلة تلال تحجز بينه وبين مخيم عين السلطان، سهل فسيح يتمطى كالجريح المتثائب ، من تلال ضفته الأخرى إلى مغطس السيد المسيح ويوحنا المعمدان إلى جسر الحسين إلى الامتداد الأسطوري لأخدود الغور ، هذا المدى الفسيح ملعبنا وساحات معاركنا الصغيرة وبستان أشعاري الأولى ، حيث يغرق أصدقاء في النهر فأرثيهم ، ويفيض النهر ليلا فيسحب معه النائمين الغافلين عل شاطئه من معارف أبي فأرثيهم ، ثم أطلب من أبي أن يعيد عليّ مِن أشعارهم ، فقد اعتاد بعضهم أن يروي في جلسات ليلية في ضيافة أبي أشعار البادية، فرسانها وأجوادها ، النبل والغدر والمروءة .
والرثاء الوحيد الذي أظنه لم يكن عيبا رثاء أقاربي الذين كانوا يجتمعون في مقهى أبي سلامة ، يتحدثون كثيرًا بأشياء يرفضون أن نعرفها نحن الصغار عندما نسحب كراسينا إلى جانبهم ، حتى إذا غابوا أياما يعود بعضهم في أكفان يقطر منها الدم ، رأيت أحدهم وقد أحضره أبناء عمومته في سيارة مصطفى عبد الدين ملفوفا ببطانية مهترئه، لم يكن له أخوة، كان له أخ وحيد جاء يوما في كفن يقطر منه الدم، لحقنا بالسيارة، أطفال ونساء وشبان ورجال يركضون وراءها إلى أن وصلت إلى بيته، زغردت أمه وبكت، أظنها زغردت وهي تبكي، أنزلوه ، كان لوح غسيل الموتى جاهزاً والماء ساخنا ، رأيته ممدداً يدلقون عليه الماء الساخن فيسيل الدم ممزوجاً بالماء على الأرض كالجدول الصغير، كان اللون ورديّا , وردة جوريّة تميل إلى البياض اللامع، اسمه سليمان ولقبه كنيبر، ممدد يفتح عينيه ويغمضهما رغم أمعائه المدلوقة ، ورغم جسده المنخل بالرصاص ، المزروع بالقطن الأبيض ، كثير من ثقوب الرصاص في جسده عارية بلا قطن، لم يكن جسداً ، كان بقايا جسد ، قال أبي : لقد ودعني قبل أسبوع قائلا : سامحني ، هل كان يعلم أنه سيموت ! ، فلماذا لم ينتظر قليلا قبل أن يذهب !! .
هؤلاء لم أخجل من رثائهم ، كنت أحبهم وأبكي عندما أخلوا بنفسي ، لأن البكاء أيضا عيب ،
كنت أخفي رثائي هذا عن أبي وأقاربي فقط ، فلم يكن كرثاء الآخرين ، انه أشبه بالفخر وروح القتال ، أذكر مما لم أخبئه :
هلْ مِنْ دُموعٍ تَنْهَمِرْ مِنْ نَرْجِسٍ غَضٍّ نَضِرْ
تَبْكـي فَتىً مُسْتَلْئِمًا لَقَـدْ أَبـَى أنْ يَنْقَهِـرْ
رَشّاشُـهُ صَوْتٌ لَهُ وَالْمَدْفَـعُ الـذي زَأَرْ
ناحَـتْ لَهُ أُمُّ الدُّنـا وَالأَرْضُ وَانْشَقَّ الْقَمَرْ
هذا من الرثاء الذي قلته عندما كبرت قليلا ، ثلاثة عشر سنة ، قريبا من عام 1965 ، بدأت أعرف حقيقة موت أقاربي ، لم يكونوا كالموتى ، بل شهداء ، يشترك كل اثنين أو ثلاثة ببندقية، يتناوبون عليها ، يتسللون إلى الدوايمة فيقتلون من اليهود ، يعود بعضهم ، وبعضهم لا يعود ، إنها لعبة الثأر والرغبة الجامحة بانتزاع أشيائهم من أيدي المستوطنين ، مهما كانت صغيرة ، فهي حميمة ، ولها عندهم معان تستحق القتال .
الغور بالنسبة لي كله عين السلطان ، حتى مدينة أريحا تلك القرية الحجرية الكبيرة ، بأسواقها وسينماتها وأعشاب المدارس في صباحها الأخضر تمشي إلى مدارسها ، كل شيء في أريحا نحن ، نحن الصغار المشاكسين قلوبنا لا تكل من التجوال ليلا نهارا في طرقاتها ، أذكر أني وصديقي سمير الشطرات كثيرا ما هززنا أشجار السرو على شعر صبايا أريحا وهن عائدات من المدرسة ، منهن من لم تلتفت لأحد ، لكنهن جميلات ، نراهن فنفرح ، نحن الصغار يعشش الجراد السكران في تجاويف قلوبنا ، قادرين على أن نحب كل جميلة ، وكل جميلة هي ملكنا الخاص ، وما أكثر الجميلات في أريحا ، وما أكثر ما نمتلك ! ، أريحا كلها ملكنا ، نكتب فيها الشعر ثم نلقيه على حواشي صبيحة والخديوي والزهور ، وربما نلصقه عل أعمدة سينما ريفولي ونذهب ، لا نبحث عنه بعد ذلك ولكن نكتب غيره ونذهب ، رأيت ابن عمي يكتب بخط جميل أسماء عشر فتيات ، سألته : ما هذه ؟ ، أجاب : أسماء من أحبهن .
كم كنا أشقياء مغرورين بأشعارنا الفطرية ، نرى أنفسنا شعراء مهمين ، نسحب الأبيات المتعجرفة من كلماتنا الريفية والبدوية لنلصقها على أعمدة سينما ريفولى ، يضربنا أساتذتنا ونخفي عن أهالينا ما نكتب ، فالكتابة عيب ، وشعر الحب عيب ، والرثاء عيب ، الضعيف هو الذي يرثي ، كنت أخبئ شعري في ثنايا أوراق لا يطالها غيري وغير الأصدقاء كاتمي الأسرار، اشتكاني ابن عم لي مرة لأبي ، قائلا : يا عم ابنك يقضي الليل في كتابة الشعر ولا يدرس ، إنه يضيع وقته ، وهو يحب ويكتب شعراً ، سألني والدي : هل تكتب الشعر، أخبَرَني ابن عمك ، اعترفت لأبي على استحياء ، ولكنه فاجأني : " هل تكتبه جيداً ، أسمعني "، خجلت ، ولكنه قال :
لا يهم ، انتبه لدروسك أيضًا .
مَنْ في عين السلطان لا يحب الشعر ؟!، غير أن أبن عمي يعتقد أن الشاعر لا يكون إلا ميتا، فأظنه خاف عليّ، ربما لا يريد أن أكون مثل عبد أبو حسين ، شاعر نَبَتَ في عين السلطان قبلي ، مشاغب إلى درجة العدوانية ، لا نراه في المجالس ، وإنما نسمع عنه في السجن أو عين الديوك أو المخيمات المجاورة ، يشاغب الشرطة ، أو تبحث عنه عيون الدولة ، أو أقارب إحدى الفتيات ، كان مطلوبا من الجميع ونادرًا ما أراه ، وإذا رأيته يكون ملثّما بحطته المرقطة ، حييته مرة فقال لي : أتحب الشعر !؟ ، قلت : سأكون شاعراً ، قال : هل ستكون مثلي !؟ .
لا أخفي أنني أحببته ، لكنه مات قتيلا وهو يخوض في مياه نهر الأردن ، انتهزت دورية
يهودية انحباسه في الماء فأطلقت عليه النار فاختطفه النهر، كان يكتب وقتها قصيدة لم تكتمل ، ولعل ابن عمي خاف علي من اليهود فوشى بي لأبي .
عبد أبو حسين وكنيبر وأنا وأمثالنا نتاج مجالس الرجال في الحارات والعشيرة ، تشربنا أدق تفاصيل تراثها حتى الثمالة ، التراث فيها غنى لا حدّ له ، فيه سيرة الأجداد وحياة العشائر والبلاد ، التقاليد والعادات والأمزجة والعقائد ، الشراسة والطيبة والدفء والبحث عن متطلبات الحياة بكل تعقيداتها ، والحياة في المضافة أو المجلس ليست كحياة البيت والشارع ، إنها تربية خاصة بكل معاني الخصوصية ، فهي انتماء وصرامة وانطلاق في الحديث بلا تكرار أو تلعثم ، فالتكرار عيب ، والتأتأة عيب ، والتردد عيب ، وغياب الفكرة عيب ، ومعاودة المعنى أو الألفاظ في غير مكانها عيب ، لذلك يتخرج طفل المجلس كتابا تراثياً مفتوحا، حَكّاءً ، متكلما غير هياب ، مبارز في الحوار ، سلس في سرد فكرته يعرف المعنى ويخوض بحوره .
أثّرَ هذا بتكويني الشخصي وأسلوب التأليف ومن ضمنه الشعر، فالعيب عيب والعبارة تتناسل من سابقتها ، والبحث عن السمات الخاصة منذ البداية ، فقد أغنتني المجالس عن المحاكاة ،
قال لي جدي : " كن أنت أنت ، لا تشبه أحداً ، تعلَّم ولكن لا تشبه أحداً " ، فاجتهدتُ من بداياتي الأولى أن أكون نفسي ، لا أتشبه بأحد . قالها لي الشاعر الكبير علي الجندي عندما عرضت عليه قصيدتي في السنة الأولى من الجامعة السورية ، عنوانها " سقوط الشفق الأحمر في الدروب الطويلة " : إنك لا تشبه أحداً ، استمرّ هكذا . وَنَشَرَتْ مجلةُ ( الموقف الأدبي ) الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق جزءاً منها ، والباقي فقدته للأبد .
ما أكثر القصائد التي فقدتها في السنوات الثلاثة الأولى من الجامعة، بعضها منشور في صحف ومجلات عربية لا أستطيع الوصول إليها، أو أنها توقفت عن الصدور منذ سنوات طويلة.
في المجالس حفظت إلى جانب البطولات الشعبية لمقاتلي جبل الخليل، وفي مقدمتهم سليمان عشا أبو نايف الملقب بالعوامة، وعلاقاتهم بمقاتلي القرى المجاورة ، سيرة بني هلال والأميرة ذات الهمة وعنترة وحرب البسوس وحمزة البهلوان وغيرها ، وكثيراً من ألف ليلة وليلة ، لم أكن تجاوزت العاشرة عندما استمعت وقرأت تلك القصص ، وبعدها حاولت قراءة ما يتهافت عليه أبناء المرحلة الإعدادية من حكايات طرزان وشرلوك هولمز وأرسين لوبين، لكنني لم أتآلف معها ، فتركتها وتوجهت إلى السينما ، حتى صرت من الرواد الأساسيين لسينما هشام وريفولي ورمسيس في أريحا،وإذا ذهبت برحلة إلى مدينة ما فأول ما أبحث عنه هو السينما، أحببت" ذهب مع الريح " و"الشيخ والبحر"، وأفلام الميثولوجيا الإغريقية واليونانية، وعنترة وأيضا وا إسلاماه الذي كان يدغدغ أشياء كامنة في دواخلي ، طالما حاولت أن أعبر عنهـا بأشعاري الأولى .
ولكن الذي شدني أكثر من هذا ما أشاهد من حلقات الذكر اليومية في مسجدنا المجاور، فأبي وعمي وأغلب رجالات الدوايمة ينتمون إلى أشهر الطرق الصوفية في بلاد الشام ، وهي الطريقة الخلوتية الإبراهيمية ، التي مركزها في الدوايمة قبل الاحتلال ، جلسات روحانية تسمو بالروح إلى آفاق لا يمكن الإحساس بها إلا مِنْ خلال تلك الأوراد ، وقصائد صوفية تثير بي شغف التجلي ورحابة الشعر ، كنت طفلاً أسقي الدراويش الماء قبيل بداية الحضرة وبعدها ، أحسست بلذة غامرة وأنا أسقيهم ، أسمع دعواتهم لي فأطرب ، وتراتيلهم فأتمنى أن أحفظها غيبا دون أن أعيش – فقط – النزوع فيها إلى الحياة المثلى المخفية ، ينشدونها الأشعار كأنها حية أمامهم يرونها رأي العين ويمارسونها ، إنها لغة الشعر الحقيقية التي تشربتها حتى النخاع ، إنها لغة الشعر وما سواها المضمون.ولا زلت أمارس الذكر في الحضرة ما استطعت ، أحب شيخ الطريقة وأقبل يديه ورأسه ، وأتمنى أن أكون معه دائما ، إنها طريقة علمتني فن الجملة الشعرية الحية، فن الصورة وسموها الصوفي الذي لا يمكن أن يتأتى لأي شاعر يحاول الكتابة الصوفية من خارج حياة التصوف ، لأنه لن يمس سوى القشور ، كأنه يقول للآخرين لدي شعر ينتمي إلى الصوفية ، بينما هو ليس إلا طائر يحوم حول الحقل دون أن يأكل منه ولو حبة قمح واحدة.
ليست تجربتي الذاتية مع إخواني من أبناء هذه الطريقة محكومة بالتجربة الشعرية ، وإنما
برغبتي الصادقة بالتطهر والاقتراب من جوهر المحبة الإلهية ولذة النور الروحاني ، تتشربها
اللغة تلقائيا ، لتكون مبثوثة في كل تعبير عن أي معنى ، وفي كل حركة وسكون ، ليس للشعر فيه غاية ، فالغاية التقرب إلى الله ومحبته سبحانه ، حتى تكون كل غاية مسخرة لهذه الغاية ، تمحو فوارق الدنيا ومراتبها مهما تعالت أو تدانت ، لتكون درجات سلم الصعود في أنوار المحبة برهان الدلالات على الترقي في مراتب العشق ، وبغير هذا لا يكون الصوفي صوفيا ، وأول خطوة نحو الدرجة الأولى من السلم أن يتخلص المريد من علائق الفوارق بالامتثال مخلصا لتعبيرٍ يتعلمه ، يمحق به كبرياءه أمام إخوانه بأن ينادي طفلهم وشيخهم : " سِيدي " ويصطف معهم في الحضرة ، يأكل من زادهم ، ويحبهم في سرِّه قبل جَهْر
فلكي يعرف الشاعر معنى الكتابة الصوفية عليه أن يكون صوفيا . أن يخوض التجربة ، لا أن يستحضرها في ذهنه وهو يشرب كأس نبيذ ، بالنبيذ تدخل الصورة المزيفة ، الصورة الميتة ، التي لا تلد إلا شعراً نبيذيا ميتاً ، شعراً يستعير مفردات ومعاني ، محاولا بها تقليد نمط التعبير الصوفي ، دون الدخول إلى جوهر هذه المعاني ولغتها ، فهو لا يمتلك أكثر من المحاكاة بدلالات محدودة ، لها بداية ونهاية ، وبالتالي شعره ليس صوفيا بالمعنى الإبداعي ، وإنما تقليداً للتعبير الصوفي ، يفتقر إلى تجربة وروح المتصوفة ودلالاتهم ، إنه كالنحت في الخشب ، لا يلد جسداً حيا ، إنما ينحت خشبا على شكل جسد إنسان ، لا بد أن يكون في النحت جماليات ، ولكنه جمال في الخشب وليس في اللحم والدم .
في هدأة المساء تدور الحضرة ، أوراد بنغم جماعي عذب ينبعث في سماء مخيم عين السلطان ، يشدني فأنساق إليه ، لا أرتاح حتى أكون فيه ، رجال بحناجر رنّانة تصدح بقصائد ينضح منها النور، نور يتدفق في رياحين القلوب في مخيم عين السلطان
هذه أرض الشعر ، تحديد الملامح الأساسية للجنين الشعري الذي لابد أن يولد ويكبر بهذه
الملامح
والرسم المُلِحُّ الصارخ الآخر الذي يشكل إطار لوحة تجربتي ، هو تلك القصص المثيرة التي يرويها المحيطون بي عن تراجيديا الطرد والاقتلاع ، والمذابح الجماعية في الدوايمة ، التي ارتكبها جنود الفرقة 89 من عتاة القتلة في عصابتي اشتيرن والأرجون ، تلك القصص المرعبة التي كانت والدتي تسردها وتتسامر بها مع الأقارب ، ويؤرخ لها الرجال في المجلس ، يروي كل واحد قصته الخاصة ، يسردها وأنا أصغي بكل جوارحي ، فرغم أنني تعلمت فن الإصغاء في المجلس إلا أنها قصص يسلب السرد فيها لبَّ المستمع ، كنت أعيش بخيالي الأحداث كأني أمارسها ، يحمل دخل الله العامري بندقية الصيد وينتخي عندما تقدمت الدبابات اليهودية نحو البلد ، قال له أبي : إلى أين يا دخل الله ببارودة الخرطوش أمام رتل الدبابات !! ، أجاب : " والله لأعطي الدار حقها " ، كان مع والدي- كما روى لي- رشاش استن ، قلت له : لماذا لم تحارب به ؟ ، قال : " حاربت ، حافظت على أمك وعماتك ومن لاذ بي من نساء البلد حتى أوصلتهن برّ الأمان ، أليس هذا عملاً بطوليا في زمن المجازر الجماعية ، لقد كان جدك علي هو العاقل الوحيد في البلد ، حَلَّ لفّة طربوشه البيضاء ، وربطها بعكازته ليسلم البلد وتسلم ، لكن أخوالك منعوه ، قالوا له أن اليهود قَتَلَة لا يقبلون بالتسليم ، إنهم يريدون الأرض بدون أهلها ، ارجع وإلا قتلوك ، أين تذهب بناتك إن تيتمن !؟ " ، عاد جدي ، ولاحقت الدبابات دخل الله العامري ، تابعوه ، كانوا يحصدون الفارين وكأنهم يكنسون البلد من أهلها ، رأوه يدخل مغارة ، أطلقوا الرشاشات داخلها ثم أخرجوا من فيها ، كان العدد هائلا ، مئات من المختبئين ، أطفال وعجائز، بنات ونساء ، آباء وأمهات ، وقليل من الشبان ، جعلوهم يصطفون صفوفا كأنهم في الصلاة ثم بدأت حفلة الموت .
روايات تفجر المخيلة ، لن يصدقها إلا من شاهدها ، وأنا صدقتها لأنني كنت مهروسا بين
أسنان السَّرد، انتقى عدد من الجنود أربع فتيات ، ربطوا أيديهن بالحبال ورموهن في دبابة ، أثارهم منظر امرأة تهدهد وليدها، دست ثديها في فمه، تقدم إليها أحد الجنود وانتزع الوليد بوحشية ، هاجمته أمه فأطلق عليها الآخر النار، ثم أمام الحشد رفع الجندي الطفل إلى الأعلى ثم رطمه بالأرض، لم يصرخ الطفل، لكن الجندي كفأه على وجهه وأحضر الآخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل ، لم يصرخ الطفل بينما تفجرت جمجمته ، والفتيات الأربع مربوطات على ظهر الدبابة ، كن ريفيات بأجساد قوية شرسة ، فكَّت إحداهن الحبال وقفزن من فوق الدبابة وبدأن بالهرب ، لكن الرشاشات أسرع منهن ، رشقنهن بصليات تقتل أربعين جملاً ، هكذا تروي والدتي ، قالت إنها نجت بأعجوبة قبل أن يجدها والدي ، كانت منكمشة وراء تلَّة تشاهد ، بدأ الناس يكبِّرون ، امرأة ثار عليها طلق الوضع ، اندفع جندي نحوها ، سَطَحَها بحربته ، غرز الحربة في جسد الوليد ثم سحبه وهو يتلعبط ، انتابت الجندي هستيريا الضحك ، ارتفع تكبير الناس ، تلاصق بعضهم وتدافع آخرون نحو الجنود ، لكن الجنود أطلقوا النار على الجميع ، أصوات الرشاشات هائلة لاحقت أيضا من حاول الإفلات ، ظلوا يطلقون الرصاص إلى أن تيقنوا أنهم قتلوا الجميع ، ظنوا ذلك ، ولكن ظل بعض من لم يلاحظ الجنود القتلة أن فيهم من كانت جراحه بسيطة، وأن في المغارة بعض الأطفال خبأتهم أمهم في مسفط الحوائج ، أم شاكر فريح استطاعت أن تختفي مع أولادها عن أعين اليهود في المغارة ، كي تروي مع أولادها شهادة المذبحة ، وسُمَيَّةُ ابنة دخل الله العامري الناجية الوحيدة من أفراد عائلتها ، أغمي عليها بين أكوام الجثث ، شاهِدُها الآن جرحها الذي تتحسسه كلما نظرت إلى المرآة ، كانت طفلة ، وهي الآن أم أبناء وبنات تروي لهم التفاصيل .
تفاصيل فظائع ضد البشرية ، تتكتم عليها الأمم المتحدة والآخرون رغم أن أدق تفاصيلها موثقة لديهم ، إنه خزي الحضارة الدموية . يصف أحد جنود الفرقة 89 في كتاب " الأسرار المذهلة للكارثة " شيئا من تفاصيل أخرى ضد الذين لم يغادروا بيوتهم في الدوايمة : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي ، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث ، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " ،
تفاصيل أخرى يرويها هذا الجندي الذي يَدَّعي أن ضميره أفاق فجأة ، وتوردها لجان التحقيق والقنصل الأمريكي في القدس ، ووزير الزراعة الإسرائيلي أهارون سيزلنغ ، لقد كان تقدير عدد القتلى ما بين سبعمائة إلى ألف ، قُتِلوا داخل البلد وعلى باب المغارة التي يسميها أهل الدوايمة ( مذبحة عراق الزاغ ) ، وفي مسجد البلدة ، ففي المسجد وحده قَتَلَ حنود الفرقة 89 أكثر من مئة وخمسين مُصَلٍّ ، لقد حدثت المذبحة أثناء صلاة يوم الجمعة ، الموافق 9/10/ 1948والناس منصرفون إلى مشاغلهم اليومية،والبلد مزدحمة باللاجئين إليها من أهالي القرى والمدن القريبة الذين نجوا من المذابح الأخرى ، إلاّ أن منهم أكثر ضحايا مذبحة الدوايمة.
يظل المخيم الشاهد الأهم على الكارثة ، ويبقي الفقر والفاقة والمرض ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة في المخيم ، أما الأرض السليبة وسيرة المذبحة فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم ، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة ، رغم أن كل ما في المخيم يرعف بها ، الشوارع ، الجدران ، المساءات ، ولعب الأولاد العنيف ، كانت ألعابنا لغة الحرب ، المبارزات والقتال والتهيئة الفطرية للثأر والعودة ، الحرب طائر العنقاء الذي ننتظره ، استدعيته في أشعاري الأولى ، أشعار تنضح بألوان الدم وأشجار الدوايمة وأريحا وسواد الموت والرؤى الناصعة النقية ، خلجات مفردات المخيم التي تشي بها أنفاس أبنائه ورياحين أجسادهم ، الأجساد التي لا تزيد عن أنها مشاريع قتلى وأسرى ، شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة ، تأتي أخبارهم أو جثثهم ، والمحظوظ منهم من لم يَمْحُ الرصاص تفاصيل جسده ، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام ، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيّا ، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة ، أعوام من الغياب ، يسرد للمهنئين وحشة الأسر والسجن ، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود ، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه ، وفلان تخلف في مغارة في البلد ، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص .
هكذا عين السلطان .. !! ، أنشودة الموت في المناطق المحرمة ، وصبر المغاور والسجون وزنازينها المظلمة ، وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة ، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر ، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة ، لا ماء لا إضاءة لا خدمات ، ليس إلا الفقر والفاقة والمرض ومغفر الشرطة والأونروى ، والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو .
أنه المخيم الذي أورثني مرارة الشعر وجمال لغتها، الدلالات والرموز وخصوبة التجربة، هذا المعين الذي أغرف منه الآن مضامين موغلة في الكثافة والتزاحم، منسوجة بخيوط الصور المركبة، المنثالة كأنها أمواج البحر المتلاطم، تستدعي ملاحين أشداء وسفن متمرسة في شَقِّ عباب العاصفة .
صور تتوالد من صور ، لا يجدي معها التصفيق ولا تستحثه ، كما لا تتوسل إلى المباشرة والخطابية، أو الرموز فقيرة الدلالات ، إنما هي صور تهيمن على المستمع وتنتزع منه دهشة الإنصات ولغة الصمت ، وفرد المخيلة على مداها وانفتاحها على آفاق جديدة مفعمة بالدلالات ،
تُحَوِّلُ الرمز إلى أسطورة على رأي الناقد الدكتور محمد صابرعبيد ، في وعاء من العبارات المشغولة بأفران جامعة دمشق، لقد انسكبت فيها أرواح أساتذة أجلاء عايشتهم في الجامعة، لهم أيد ماهرة بصياغة اللغة العربية السليمة بما يمكن أن نطلق عليه الكلاسيكية الجديدة، ومن ثم انسياق هذه الصياغة مع أساليب التعبير الشعري المعاصر، الذي اكتسبته من الإندماج بالساحة الثقافية بدمشق في تأججها الإبداعي، بحيث غادرت دمشق بينما كنت محسوبا على جيل النصف الأول من السبعينات في سوريا، الجيل الذي كرسته جريدة الثورة في عدد خاص بهم أوائل عام 1975 ، وكانوا ستة شعراء فقط .
لقد فتحت أمامي الساحة الشعرية في دمشق جغرافية الشعر الجديد، وجعلتني أنطلق عليها يكل حرية ، استفدت خلالها من الإحتكاك الشخصي بتجارب شعرائها الكبار، وبالتفاعل الصاخب مع أبناء جيلي فيها، لي حوارات عالية مؤثرة مع زملائي سليمان الأزرعي وعبد الله أبو هيف وحسين حموي والمرحوم نزار عدرا، وعبد الله غيث الذي توقعنا له مستقبلا نقديا باهرا ، لكنه اختفى ورسمي المدهون، وغيرهم . كما فتح الناقد الكبير خلدون الشمعة أمامي أهم المنابر الثقافية الدمشقية بحيث غادرت الجامعة أواخر عام 1975 شاعرا جاهزاً، حسب رأي الشاعر الكبير علي الجندي .
أعطيت نفسي كامل حريتي الإبداعية ، كنت متأججا ، أعتمد التجريب وتخطي الأنماط السائدة والمرفوض شعريا، فنشرت في عمان قصيدة النثر عام 1972، احتفى بها الدكتور إبراهيم خليل، مثلما كان خليل السواحري يحتفي بكتاباتي بشكل متميز .
أثرى تنوع أمكنة المناخات الثقافية العربية التي أعايش يومياتها حريتي الإبداعية ، مما جعل قصيدتي تتفاعل مع تلك الأمكنة ، وتسقط على حيثياتها دلالات خاصة بي ، لم يتناولها أحد بنفس اللغة التي شكلتها ، كما هو واضح في قصائد الخيل ، والبحر ، والجسد ، والجمر ، وغيرها ، وما تزال التجربة مستمرة مع ذلك التنوع المتوازي مع هجراتي المتعددة ، الأمر الذي يجعلني محتفيا بكل أنواع الشعر .
إنها النزعة الإبداعية المنفعلة أو لأقل المشوية مع ما ورثتها من الآتون الملتهب في أرض الشعر في أريحا ، الآتون الذي يدعى" عين السلطان" .
من خلال نزعة ابداعية تولدت من تنوع مناخات الأمكنة وما ورثته إنها النزعة الإبداعية المنفعلة أو لأقل المشوية مع ما ورثتها من الآتون الملتهب في أرض الشعر في أريحا ، الآتون الذي يدعى" عين السلطان" .
ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة ، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر ، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة ، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو، انه المخيم الذي أورثني مرارة الشعر وجمال لغته .
يالك من مخيم ، تتنفس جمالا برغم أنك تخوض في مرارة القهر ، وأن ساكنيك أبأس مظلومين في التاريخ البشري، جور انسل إليهم من عصور الغابات الأولى، هو أشدها وحشية، أنف أن يمارسه أي وحش من وحوش ما قبل التاريخ، فانسل الآن ومارسه عالم يهودي متوحش، يمتطي حضارة أوروبية متوحشة، أي وحشية أكثر قسوة ممن ينكر وجود إنسان حيا أمامه، هاهي الصليبية الجديدة تمحيك عن خارطة الحياة، وتكبت زفراتك زنازين لا حصر لها، وليس أمامك إلى أن تقاتل، وإذا كان لا بدّ من الموت، فلتقاتل لتحيا .
شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة، تأتي أخبارهم أو جثثهم، والمحظوظ منهم من لم يمح الرصاص تفاصيل جسده، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيا، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة، أعوام من الغياب، للمهنئين وحشة الأسر والسجن، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه، وفلان تخلف في مغارة في البلد، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص، وهكذا.، عين السلطان أنشودة الموت في المناطق المحرمة، أنشودة المغاور والسجون وزنازينها المظلمة، لكل إنسان فيه قصه ، حفظت منها ما سمعته من أصحابها، الطرد والاقتلاع وهدم البيوت والمجازر الجماعية، حدثني والدي عن مشاهداته لمذبحة الدوايمة وحدثتني والدتي عن نجاتها بالمصادفة ومشاهداتها الدامية للمذبحة قالت أن جنود الفرقة 19 من جنود وضباط عصابتي اشتيرن والهاجاناة كانوا يتسلون بقتل الأطفال أمام الناس، قصصا مفجعة روتها لي والدي ، ذكرت لي أسماء من شاهدتهم من الناس وكيف ذبحهم اليهود، قالت رأى أحدهم أما تدس ثديها في فم طفلها، ضحك اليهودي عاليا وانتزع الطفل من حضن أمه، رفعه بين يديه ورطمه بالأرض ثم كفأه على وجهه، أحضر جندي آخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل وصعد فوقه، وعندما هجمت أمه لتخلص طفلها أطلقوا عليها النار، وأمرأة أخرى حاملا بقر أحدهم بطنها بحربته وأخرج جنينها وهو انتابته نوبة ضحك هستيرية، قصة طويلة مرعبة يرويها الناجون من المذبحة، حتى أن أحد جنود الفرقة 89 التي ارتكبتها ادعى صحوة ضميره فقال : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي ، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث ، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
يظل المخيم الشاهد الأهم على المأساة، ويبقي الفقر والفاقة ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة في المخيم ، أما الأرض السليبة فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة، رغم أن كل ما في المخيم يشي بها حتى أنفاس أبنائه وروائه أجسادهم ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى، أسقف متلاصقة، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو . أنه المخيم الذي أورثني مرارة اشعر وجمال لغته .
في المجلس ، يتحدثون عن محاولاتهم الحصول على السلاح للدفاع عن البلد فلم يجدوا من يبيع لهم ، اضطروا وأقصى ما استطاعوا الحصول عليه لا يزيد على أصابع الكفين، وما ذا تفيد، بنادق صيد وبنادق كحل وطبنجات، لعل والدي الوحيد الذي استطاع الحصول عل رشاش صغير له مهمة واحدة هي الدفاع عن أمي وعماتي ونساء العشيرة ومن يلوذ به من النساء، مهمة صعبة أمام دروع الهجاناة واشتيرن والقتلة من الكتيبة 89، ولكن لابد من ذلك ، استطاع أن ينجو بهن , أما الذين لم يستطيعوا فقد تحولوا إلى ضحايا لأفظع وأبشع مجازر القتل الجماعي في فلسطين ، حدث هذا في ظهيرة يوم الجمعة الموافق 9/10/1948 ،
حيث تقدر بعض لجان الأمم المتحدة ضحاياها حسبما ورد في كتاب " الأسرار المذهلة للكارثة الفلسطينية " تأليف مايكل بالومبو، ترجمة د. فهمي شما بأربعماية وخمسين، فقد ورد فيه على لسان أحد الشهود أن في مسجد القرية وحده قتل الجنود الإسرائيليون مئة وخمسين ،و يقدر القنصل الأمريكي في القدس وليم بيردت القتلى الآخرين في البلدة بثلاثمئة، فقد جاء في رسالته التي بعثها إلى واشنطن بخصوص هذه المذبحة" المراقبون غير قادرين على تحديد عدد الأشخاص المشمولين بتلك المذبحة وتختلف التقديرات بشكل كبير ، ولكن من المرجح أن يكون هنالك حوالي " ثلاثمائة عربي قد قتلوا في تلك البلدة ". ويقول وزير الزراعة الإسرائيلي في ذلك الوقت أهارون سيزلنغ في رسالة إلى أعضاء الحكومة الإسرائيلية : "لقد تصرف اليهود مثل النازيين وإن كياني يرتعش من جراء تلك الوحشية " ، وفي نفس الكتاب يصف أحد " جنود الفرقة 89 التي تتكون من إرهابيين سابقين من عصابتي الارجون واشتيرن بقوله : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
عصر لا مثيل له على وجه الأرض، تعلمنا منه ذوق الجمال فيل أن نعرفه، وعلمنا فطرة المحبة تلك التي نبتت في أحاسيسنا دون أن نفكر بها، كان العصر ممتلئا بالصبايا والثياب المطرزة، والغدف البيضاء كأنهن أسراب من الأوز الأبيض والملون .
يالك من مخيم ، تتنفس جمالا يرغم أنك تخوض في مرارة المجازر الجماعية، مجازر ينكرها الآخرون، الكل يدعي البراءة، مجزرة الدوايمة إحداها، ولكنها أكبرها عدداً، يقدر بعض المراجعين التاريخيين الإسرائيليين عدد ضحاياها بسبعماية بينما تقدرهم تقارير بعض لجان الأمم المتحدة بأربعماية وخمسين، بينما يقدرهم الناجون بأكثر من ذلك، لم تكن الضحايا من الدوايمة وحدها، وإنما أغلبهم من أبناء القرى والمدن القريبة، لجأوا إليها منذ أيام أو شهور ناجين بأنفسهم من الإبادة .
يا لك من مخيم، ساكنوك بقاياها، حالفهم الحظ فعاشوا، وأنا من مخلفات هذه البقايا، ولدت في المخيم، وصرت واحداً من ملامحه، شاهداً له وعليه ، مخيم ساكنوه ضحايا بريئة لأبأس جور في التاريخ البشري، جور انسل إليهم من عصور الغابات الأولى، هو أشدها وحشية ، أنف أن يمارسه أشد الوحوش الكاسرة عدوانية ولؤما وخسة من وحوش ما قبل التاريخ، فانسل الآن ومارسته وحوش يهودية، تمتطي حضارة أوروبية نهشت لحم عشرات الملايين من جرائها في حربين كونيتين لا مبررات مقنعة لهما إلا التعطش للدم ، إنه الوحش الكامن فيهم يولغ في دمائهم . أي قسوة أفظع خسة ولؤما ممن تجلس معه على نفس الطاولة ثم يخاطبك أنه لا يراك ، يرى كل شيء حوله ، الطاولة والكرسي وكأس الشاي لكنه لا يراك ، ينكرك وينكرك إرضاء له أكلة لحوم أبنائهم رغم أنهم يرونك ويحسون بك ويصرون أنك خرافة، هاهي الصليبية الجديدة تمحيك عن خارطة الحياة، وتكبت زفراتك زنازين لا حصر لها، وليس أمامك إلى أن تقاتل، وإذا كان لا بدّ من الموت فلتقاتل لتحيا .
شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة ، تأتي أخبارهم أو جثثهم ، والمحظوظ منهم من لم يمح الرصاص تفاصيل جسده ، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام ، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيا، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة ، أعوام من الغياب، يسرد للمهنئين وحشة الأسر والسجن ، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود ، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه ، وفلان تخلف في مغارة في البلد، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص ، وهكذا..، عين السلطان أنشودة الموت في المناطق المحرمة، أنشودة المغاور والسجون وزنازينها المظلمة، ينكره سواه ولكنه يصرّ على إعلان وجوده .
لكل إنسان فيه قصه، حفظت منها ما سمعته من أصحابها ، الطرد والاقتلاع وهدم البيوت والمجازر الجماعية، حدثني والدي عن مشاهداته لمذبحة الدوايمة وحدثتني والدتي عن نجاتها بالمصادفة ومشاهداتها الدامية للمذبحة قالت أن جنود الفرقة 89 من جنود وضباط عصابتي اشتيرن والهاجاناة كانوا يتسلون بقتل الأطفال أمام الناس ، قصصا مفجعة روتها لي، ذكرت أسماء من شاهدتهم وكيف ذبحهم اليهود ، قالت رأى أحد الجنود أما تدس ثديها في فم طفلها ، ضحك اليهودي عاليا وانتزع الطفل من حضن أمه ، رفعه بين يديه ورطمه بالأرض ثم كفأه على وجهه ، أحضر جندي آخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل وصعد فوقه، وعندما هجمت أمه عليه أطلقوا عليها النار، وامرأة أخرى كانت حاملا بقر أحدهم بطنها بحربته، أخرج جنينها فانتابته نوبة ضحك هستيرية، قصص طويلة مرعبة يرويها الناجون من المذبحة، حتى أن أحد جنود الفرقة 89 تلك ،ادعى - متأخراً - صحوة ضميره فقال : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
يظل المخيم الشاهد الأهم على المأساة، ويبقي الفقر والفاقة ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة فيه، أما الأرض السليبة القرى والمدن، البساتبن والكروم، الزروع والمحلات التجارية والمضارب، الدروب والطرقات والحارات، الليالي المقمرة وشموس الصباحات، والمساءات المفعمة بالمسرات، فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة، رغم أن كل ما في المخيم يشي بها حتى أنفاس أبنائه وروائه أجسادهم ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو .أنه المخيم الذي أورثني مرارة اشعر وجمال لغته .
في المجلس، يتحدثون عن محاولاتهم الحصول على السلاح للدفاع عن البلد لم يجدوا من يبيع لهم، اضطروا وأقصى ما استطاعوا الحصول عليه لا يزيد على أصابع الكفين، وما ذا تفيد، بنادق صيد وبنادق كحل وطبنجات، لعل والدي الوحيد الذي استطاع الحصول عل رشاش صغير له مهمة واحدة هي الدفاع عن أمي وعماتي وعرض العشيرة ومن يلوذ به من النساء، مهمة صعبة أمام دروع ا?
بي دي ان |
09 نوفمبر 2020 الساعة 10:55م

جميل أبو صبيح
إشاعة سرت بيننا ، نحن أطفال عين السلطان أن على هذا الجبل أراد الشيطان أن يخدع سيدنا عيسى لكنه لم يستطع ، تحاور معه ، طلب منه أن يلقي بنفسه إلى أسفل ويجرب الموت ، فإن بقي حياّ فسيؤمن به ، كان المسيح صائما ، لذلك سمي جبل التجربة . أما قرنطل فقد ظل غامضا مثله ، يثير فينا الرهبة والاحترام ، وكنا دائما نرى الشيطان واقفا على عمامة الجبل يحاور سيدنا عيسى ، فنلعنه .
أما الدير فهو البناء الأسطوري المبني في الهواء ، الملتصق بجدار سحيق في بطن قرنطل ، يثير فينا الدهشة والتساؤل والفخر الغامض ورغبة اكتشاف سرِّ الدير وغموض الجبل .
نحن أطفال عين السلطان عجيبون . لم نمَلّ روتين الجبل وهو يفرد علينا عصر كل يوم عباءة ظله حتى تنسحب أطرافها على امتداد أنظارنا إلى جبال البلقاء ، يأتينا المساء منه قبل أي مكان أخر على وجه الأرض ، فينسج لنا قبل هبوط العتمة عصرا يسقينا كأس الجمال وعذرية الأنثى ، زرافات يذرعن طريق العين ، على رؤوسهن الجرار وآنية الماء ، لم يكن يملأن آنيتهن ماء وإنما يملأن قلوبهن بعصافير الحب وقسدرة المساء ، وكنا نصطادهن ، بعيوننا وكلماتنا الراعفة ، ألوان مطرزة من سنابل الدوايمة وعجور وبئر السبع وما احتوى الشتات الفلسطيني ، ألوان شتى ، نوافيرَ نوافيرَ ، روح الفطرة وينابيع أقواس قزح تلمع حقولا يانعة على الطريق الممتدة من مقهى أبو سلامة إلى نبعة العين ، وحتى شارع المنتزهات .
نبعة العين التي تروي الظمآن ولا يعطش بعدها زمنا ، مياه أزلية تجري في جداول موغلة في القدم ، بنى على ضفتها أجدادنا حضارة الإنسان الأولى ، أول محراث يشق ترابا فيبذر حقلا ويعطي الإنسان لقمة خبزه ، أول إنسان يقدم لأخيه الإنسان حضارته ، كنا فخورين نحن أبناء عين السلطان بعين السلطان ، نمسك بأصابعنا العظام البالية في شوارعه ، نتأملها ثم نعيدها إلى التراب ، نشاكس بعثات الآثار المتعددة وبخاصة من الأجانب ، ونطلق على بعضها أسماء خاصة بنا ، كانت امرأة إنجليزية نلقبها " سعيدة باي باي " ، دائما تقول لنا " بَايْ باي " ، دون أن نعلم معنى كلامها ، لكنه يثير فينا الألفة وغموض المقابر التي تحفرها في ساحات بيوتنا وغرف نومنا ، فنرى داخلها فرساناً ممددين إلى جانب خيولهم وسيوفهم ودروعهم .
أثار هذا فينا غموض تلة عين السلطان ؛ نتسلل إليها كي نرى بقايا الجنود الكنعانيين على أسوار أريحا ، جنود قاتلوا حتى آخر مقاتل فيهم ، انتهت سهامه وانكسر سيفه وتكاثف حوله الغزاة ، لقد عرفنا قصة الزانية راحاب ويوشع الذي امتطى ظهور الزانيات في دخول مدن
الكنعانيين رأينا الماضي حاضراً جداًّ، منتصباً أمامنا، نحن أبناء عين السلطان، ولدنا في المخيم وترعرعنا تحت خيامه، وآباؤنا يجتمعون في مجالسه بعد أن يفرد قرنطل عتمته، يتحدثون عن تفاصيل حياتهم الضائعة في قرانا المسروقة ، كانت المجالس مدرستي الأولى والأهم، تعلمت فيها حكايا الدوايمة وأسرارها، ألفاظها ومصطلحاتها ويومياتها مع البدو، والجرأة النادرة في الليالي الحالكة ، على امتداد جنوب فلسطين وشرقي الأردن إلى ديار بني صخر، حياة تضج بالحياة تلك التي حفظتُ أدق تفاصيلها في مخيلتي، حتى صرت أعيشها ممزوجة بتفاصيل عين السلطان .
وفي عين السلطان مساء لا شبيه له، روائح الليمون على طرقات البساتين، وشقائق النعمان
منثورة على حواف الإسفلت ، والفتيان الفالتون من عتبات بيوتهم يطاردون فراشات المساء بفساتينها الملونة ، فساتين تشتعل على بوابات شوارع صبيحة والزهور والخديوي .
الخديوي، هذا الاسم الذي وفد إلينا من أحد حكام مصر في العهد التركي، كان عثمانيا يستطيب عين السلطان، فيقضي بها وقتا في طريقه إلى الأستانة. لم يُخلق شيء لم يمرّ بعين السلطان . قال الطبري في تاريخه أن مياه عين السلطان "أعذب ماء على وجه الأرض وأخفه على المعدة "، لذلك اغتالها اليهود عندما نهض يوشع جديدأ من قبره .
كل ذرة في عين السلطان شاهدة على إحدى تفاصيل التاريخ، غرفناها براحاتنا تأملناها بملئ أبصارنا وتعلمنا منها ماضينا وحاضرنا دون طباشير أو غرف مدرسية ، كانت التراب كما هو ، التراب المنثور بعصبية وعفوية في ساحات دواخلنا ، يثور فينا ولا نبحث عنه ، لقد كان تراب عين السلطان نحن ، ونحن أبناء أريحا أحفاد الأجداد ، نباتات الأساطير الأولى التي نفثت فينا عوالم الشعر والرواية والقصة والفن التشكيلي، وكل ما يحوكه مغزل النساج الأول. حائك الفطرة الأولى على مقاساتنا .
عين الديوك واد يتمدد بين يدي والده الشيخ الصخري ، مفعم بالبساتين والنخيل والموز ، لنا حكايات وحكايات بين أشجار موزه الكثيفة ، نترصد السارحات ، يرعين أغنامهن أو يلتقطن نباتات الخبيزة ، نملأ أيضا قمصاننا وبنطلوناتنا بأنواع مختلفة من نباتات فصل الربيع ونحن نكذب على أهلينا أننا ذاهبون للدراسة، لم يمنعنا شيء قط ، حتى أصحاب البساتين ونواطيرها لم يقدروا علينا ، لنا حكايات وحكايات مع ناطور دير قرنطل، جعلناه يوما يخلع بنطاله ثم يترجانا بعد أن هددناه ببندقيته، خلّصناها منه وقلنا له أنه لن يأخذها إلا إذا خلع بنطاله، خلعه ثم أفرغنا الخرطوش منها وأعطيناها له ، كان الدير سرّا غامضا فاعتليناه وشاكسنا نواطيره ونواطير عين الديوك ، وطالبات المدارس في رحلاتهن إلى عين الديوك ، لم يكن شيء أعذب من المشاكسة .
على ضفة عين الديوك الأخرى سلسلة تلال تحجز بينه وبين مخيم عين السلطان، سهل فسيح يتمطى كالجريح المتثائب ، من تلال ضفته الأخرى إلى مغطس السيد المسيح ويوحنا المعمدان إلى جسر الحسين إلى الامتداد الأسطوري لأخدود الغور ، هذا المدى الفسيح ملعبنا وساحات معاركنا الصغيرة وبستان أشعاري الأولى ، حيث يغرق أصدقاء في النهر فأرثيهم ، ويفيض النهر ليلا فيسحب معه النائمين الغافلين عل شاطئه من معارف أبي فأرثيهم ، ثم أطلب من أبي أن يعيد عليّ مِن أشعارهم ، فقد اعتاد بعضهم أن يروي في جلسات ليلية في ضيافة أبي أشعار البادية، فرسانها وأجوادها ، النبل والغدر والمروءة .
والرثاء الوحيد الذي أظنه لم يكن عيبا رثاء أقاربي الذين كانوا يجتمعون في مقهى أبي سلامة ، يتحدثون كثيرًا بأشياء يرفضون أن نعرفها نحن الصغار عندما نسحب كراسينا إلى جانبهم ، حتى إذا غابوا أياما يعود بعضهم في أكفان يقطر منها الدم ، رأيت أحدهم وقد أحضره أبناء عمومته في سيارة مصطفى عبد الدين ملفوفا ببطانية مهترئه، لم يكن له أخوة، كان له أخ وحيد جاء يوما في كفن يقطر منه الدم، لحقنا بالسيارة، أطفال ونساء وشبان ورجال يركضون وراءها إلى أن وصلت إلى بيته، زغردت أمه وبكت، أظنها زغردت وهي تبكي، أنزلوه ، كان لوح غسيل الموتى جاهزاً والماء ساخنا ، رأيته ممدداً يدلقون عليه الماء الساخن فيسيل الدم ممزوجاً بالماء على الأرض كالجدول الصغير، كان اللون ورديّا , وردة جوريّة تميل إلى البياض اللامع، اسمه سليمان ولقبه كنيبر، ممدد يفتح عينيه ويغمضهما رغم أمعائه المدلوقة ، ورغم جسده المنخل بالرصاص ، المزروع بالقطن الأبيض ، كثير من ثقوب الرصاص في جسده عارية بلا قطن، لم يكن جسداً ، كان بقايا جسد ، قال أبي : لقد ودعني قبل أسبوع قائلا : سامحني ، هل كان يعلم أنه سيموت ! ، فلماذا لم ينتظر قليلا قبل أن يذهب !! .
هؤلاء لم أخجل من رثائهم ، كنت أحبهم وأبكي عندما أخلوا بنفسي ، لأن البكاء أيضا عيب ،
كنت أخفي رثائي هذا عن أبي وأقاربي فقط ، فلم يكن كرثاء الآخرين ، انه أشبه بالفخر وروح القتال ، أذكر مما لم أخبئه :
هلْ مِنْ دُموعٍ تَنْهَمِرْ مِنْ نَرْجِسٍ غَضٍّ نَضِرْ
تَبْكـي فَتىً مُسْتَلْئِمًا لَقَـدْ أَبـَى أنْ يَنْقَهِـرْ
رَشّاشُـهُ صَوْتٌ لَهُ وَالْمَدْفَـعُ الـذي زَأَرْ
ناحَـتْ لَهُ أُمُّ الدُّنـا وَالأَرْضُ وَانْشَقَّ الْقَمَرْ
هذا من الرثاء الذي قلته عندما كبرت قليلا ، ثلاثة عشر سنة ، قريبا من عام 1965 ، بدأت أعرف حقيقة موت أقاربي ، لم يكونوا كالموتى ، بل شهداء ، يشترك كل اثنين أو ثلاثة ببندقية، يتناوبون عليها ، يتسللون إلى الدوايمة فيقتلون من اليهود ، يعود بعضهم ، وبعضهم لا يعود ، إنها لعبة الثأر والرغبة الجامحة بانتزاع أشيائهم من أيدي المستوطنين ، مهما كانت صغيرة ، فهي حميمة ، ولها عندهم معان تستحق القتال .
الغور بالنسبة لي كله عين السلطان ، حتى مدينة أريحا تلك القرية الحجرية الكبيرة ، بأسواقها وسينماتها وأعشاب المدارس في صباحها الأخضر تمشي إلى مدارسها ، كل شيء في أريحا نحن ، نحن الصغار المشاكسين قلوبنا لا تكل من التجوال ليلا نهارا في طرقاتها ، أذكر أني وصديقي سمير الشطرات كثيرا ما هززنا أشجار السرو على شعر صبايا أريحا وهن عائدات من المدرسة ، منهن من لم تلتفت لأحد ، لكنهن جميلات ، نراهن فنفرح ، نحن الصغار يعشش الجراد السكران في تجاويف قلوبنا ، قادرين على أن نحب كل جميلة ، وكل جميلة هي ملكنا الخاص ، وما أكثر الجميلات في أريحا ، وما أكثر ما نمتلك ! ، أريحا كلها ملكنا ، نكتب فيها الشعر ثم نلقيه على حواشي صبيحة والخديوي والزهور ، وربما نلصقه عل أعمدة سينما ريفولي ونذهب ، لا نبحث عنه بعد ذلك ولكن نكتب غيره ونذهب ، رأيت ابن عمي يكتب بخط جميل أسماء عشر فتيات ، سألته : ما هذه ؟ ، أجاب : أسماء من أحبهن .
كم كنا أشقياء مغرورين بأشعارنا الفطرية ، نرى أنفسنا شعراء مهمين ، نسحب الأبيات المتعجرفة من كلماتنا الريفية والبدوية لنلصقها على أعمدة سينما ريفولى ، يضربنا أساتذتنا ونخفي عن أهالينا ما نكتب ، فالكتابة عيب ، وشعر الحب عيب ، والرثاء عيب ، الضعيف هو الذي يرثي ، كنت أخبئ شعري في ثنايا أوراق لا يطالها غيري وغير الأصدقاء كاتمي الأسرار، اشتكاني ابن عم لي مرة لأبي ، قائلا : يا عم ابنك يقضي الليل في كتابة الشعر ولا يدرس ، إنه يضيع وقته ، وهو يحب ويكتب شعراً ، سألني والدي : هل تكتب الشعر، أخبَرَني ابن عمك ، اعترفت لأبي على استحياء ، ولكنه فاجأني : " هل تكتبه جيداً ، أسمعني "، خجلت ، ولكنه قال :
لا يهم ، انتبه لدروسك أيضًا .
مَنْ في عين السلطان لا يحب الشعر ؟!، غير أن أبن عمي يعتقد أن الشاعر لا يكون إلا ميتا، فأظنه خاف عليّ، ربما لا يريد أن أكون مثل عبد أبو حسين ، شاعر نَبَتَ في عين السلطان قبلي ، مشاغب إلى درجة العدوانية ، لا نراه في المجالس ، وإنما نسمع عنه في السجن أو عين الديوك أو المخيمات المجاورة ، يشاغب الشرطة ، أو تبحث عنه عيون الدولة ، أو أقارب إحدى الفتيات ، كان مطلوبا من الجميع ونادرًا ما أراه ، وإذا رأيته يكون ملثّما بحطته المرقطة ، حييته مرة فقال لي : أتحب الشعر !؟ ، قلت : سأكون شاعراً ، قال : هل ستكون مثلي !؟ .
لا أخفي أنني أحببته ، لكنه مات قتيلا وهو يخوض في مياه نهر الأردن ، انتهزت دورية
يهودية انحباسه في الماء فأطلقت عليه النار فاختطفه النهر، كان يكتب وقتها قصيدة لم تكتمل ، ولعل ابن عمي خاف علي من اليهود فوشى بي لأبي .
عبد أبو حسين وكنيبر وأنا وأمثالنا نتاج مجالس الرجال في الحارات والعشيرة ، تشربنا أدق تفاصيل تراثها حتى الثمالة ، التراث فيها غنى لا حدّ له ، فيه سيرة الأجداد وحياة العشائر والبلاد ، التقاليد والعادات والأمزجة والعقائد ، الشراسة والطيبة والدفء والبحث عن متطلبات الحياة بكل تعقيداتها ، والحياة في المضافة أو المجلس ليست كحياة البيت والشارع ، إنها تربية خاصة بكل معاني الخصوصية ، فهي انتماء وصرامة وانطلاق في الحديث بلا تكرار أو تلعثم ، فالتكرار عيب ، والتأتأة عيب ، والتردد عيب ، وغياب الفكرة عيب ، ومعاودة المعنى أو الألفاظ في غير مكانها عيب ، لذلك يتخرج طفل المجلس كتابا تراثياً مفتوحا، حَكّاءً ، متكلما غير هياب ، مبارز في الحوار ، سلس في سرد فكرته يعرف المعنى ويخوض بحوره .
أثّرَ هذا بتكويني الشخصي وأسلوب التأليف ومن ضمنه الشعر، فالعيب عيب والعبارة تتناسل من سابقتها ، والبحث عن السمات الخاصة منذ البداية ، فقد أغنتني المجالس عن المحاكاة ،
قال لي جدي : " كن أنت أنت ، لا تشبه أحداً ، تعلَّم ولكن لا تشبه أحداً " ، فاجتهدتُ من بداياتي الأولى أن أكون نفسي ، لا أتشبه بأحد . قالها لي الشاعر الكبير علي الجندي عندما عرضت عليه قصيدتي في السنة الأولى من الجامعة السورية ، عنوانها " سقوط الشفق الأحمر في الدروب الطويلة " : إنك لا تشبه أحداً ، استمرّ هكذا . وَنَشَرَتْ مجلةُ ( الموقف الأدبي ) الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق جزءاً منها ، والباقي فقدته للأبد .
ما أكثر القصائد التي فقدتها في السنوات الثلاثة الأولى من الجامعة، بعضها منشور في صحف ومجلات عربية لا أستطيع الوصول إليها، أو أنها توقفت عن الصدور منذ سنوات طويلة.
في المجالس حفظت إلى جانب البطولات الشعبية لمقاتلي جبل الخليل، وفي مقدمتهم سليمان عشا أبو نايف الملقب بالعوامة، وعلاقاتهم بمقاتلي القرى المجاورة ، سيرة بني هلال والأميرة ذات الهمة وعنترة وحرب البسوس وحمزة البهلوان وغيرها ، وكثيراً من ألف ليلة وليلة ، لم أكن تجاوزت العاشرة عندما استمعت وقرأت تلك القصص ، وبعدها حاولت قراءة ما يتهافت عليه أبناء المرحلة الإعدادية من حكايات طرزان وشرلوك هولمز وأرسين لوبين، لكنني لم أتآلف معها ، فتركتها وتوجهت إلى السينما ، حتى صرت من الرواد الأساسيين لسينما هشام وريفولي ورمسيس في أريحا،وإذا ذهبت برحلة إلى مدينة ما فأول ما أبحث عنه هو السينما، أحببت" ذهب مع الريح " و"الشيخ والبحر"، وأفلام الميثولوجيا الإغريقية واليونانية، وعنترة وأيضا وا إسلاماه الذي كان يدغدغ أشياء كامنة في دواخلي ، طالما حاولت أن أعبر عنهـا بأشعاري الأولى .
ولكن الذي شدني أكثر من هذا ما أشاهد من حلقات الذكر اليومية في مسجدنا المجاور، فأبي وعمي وأغلب رجالات الدوايمة ينتمون إلى أشهر الطرق الصوفية في بلاد الشام ، وهي الطريقة الخلوتية الإبراهيمية ، التي مركزها في الدوايمة قبل الاحتلال ، جلسات روحانية تسمو بالروح إلى آفاق لا يمكن الإحساس بها إلا مِنْ خلال تلك الأوراد ، وقصائد صوفية تثير بي شغف التجلي ورحابة الشعر ، كنت طفلاً أسقي الدراويش الماء قبيل بداية الحضرة وبعدها ، أحسست بلذة غامرة وأنا أسقيهم ، أسمع دعواتهم لي فأطرب ، وتراتيلهم فأتمنى أن أحفظها غيبا دون أن أعيش – فقط – النزوع فيها إلى الحياة المثلى المخفية ، ينشدونها الأشعار كأنها حية أمامهم يرونها رأي العين ويمارسونها ، إنها لغة الشعر الحقيقية التي تشربتها حتى النخاع ، إنها لغة الشعر وما سواها المضمون.ولا زلت أمارس الذكر في الحضرة ما استطعت ، أحب شيخ الطريقة وأقبل يديه ورأسه ، وأتمنى أن أكون معه دائما ، إنها طريقة علمتني فن الجملة الشعرية الحية، فن الصورة وسموها الصوفي الذي لا يمكن أن يتأتى لأي شاعر يحاول الكتابة الصوفية من خارج حياة التصوف ، لأنه لن يمس سوى القشور ، كأنه يقول للآخرين لدي شعر ينتمي إلى الصوفية ، بينما هو ليس إلا طائر يحوم حول الحقل دون أن يأكل منه ولو حبة قمح واحدة.
ليست تجربتي الذاتية مع إخواني من أبناء هذه الطريقة محكومة بالتجربة الشعرية ، وإنما
برغبتي الصادقة بالتطهر والاقتراب من جوهر المحبة الإلهية ولذة النور الروحاني ، تتشربها
اللغة تلقائيا ، لتكون مبثوثة في كل تعبير عن أي معنى ، وفي كل حركة وسكون ، ليس للشعر فيه غاية ، فالغاية التقرب إلى الله ومحبته سبحانه ، حتى تكون كل غاية مسخرة لهذه الغاية ، تمحو فوارق الدنيا ومراتبها مهما تعالت أو تدانت ، لتكون درجات سلم الصعود في أنوار المحبة برهان الدلالات على الترقي في مراتب العشق ، وبغير هذا لا يكون الصوفي صوفيا ، وأول خطوة نحو الدرجة الأولى من السلم أن يتخلص المريد من علائق الفوارق بالامتثال مخلصا لتعبيرٍ يتعلمه ، يمحق به كبرياءه أمام إخوانه بأن ينادي طفلهم وشيخهم : " سِيدي " ويصطف معهم في الحضرة ، يأكل من زادهم ، ويحبهم في سرِّه قبل جَهْر
فلكي يعرف الشاعر معنى الكتابة الصوفية عليه أن يكون صوفيا . أن يخوض التجربة ، لا أن يستحضرها في ذهنه وهو يشرب كأس نبيذ ، بالنبيذ تدخل الصورة المزيفة ، الصورة الميتة ، التي لا تلد إلا شعراً نبيذيا ميتاً ، شعراً يستعير مفردات ومعاني ، محاولا بها تقليد نمط التعبير الصوفي ، دون الدخول إلى جوهر هذه المعاني ولغتها ، فهو لا يمتلك أكثر من المحاكاة بدلالات محدودة ، لها بداية ونهاية ، وبالتالي شعره ليس صوفيا بالمعنى الإبداعي ، وإنما تقليداً للتعبير الصوفي ، يفتقر إلى تجربة وروح المتصوفة ودلالاتهم ، إنه كالنحت في الخشب ، لا يلد جسداً حيا ، إنما ينحت خشبا على شكل جسد إنسان ، لا بد أن يكون في النحت جماليات ، ولكنه جمال في الخشب وليس في اللحم والدم .
في هدأة المساء تدور الحضرة ، أوراد بنغم جماعي عذب ينبعث في سماء مخيم عين السلطان ، يشدني فأنساق إليه ، لا أرتاح حتى أكون فيه ، رجال بحناجر رنّانة تصدح بقصائد ينضح منها النور، نور يتدفق في رياحين القلوب في مخيم عين السلطان
هذه أرض الشعر ، تحديد الملامح الأساسية للجنين الشعري الذي لابد أن يولد ويكبر بهذه
الملامح
والرسم المُلِحُّ الصارخ الآخر الذي يشكل إطار لوحة تجربتي ، هو تلك القصص المثيرة التي يرويها المحيطون بي عن تراجيديا الطرد والاقتلاع ، والمذابح الجماعية في الدوايمة ، التي ارتكبها جنود الفرقة 89 من عتاة القتلة في عصابتي اشتيرن والأرجون ، تلك القصص المرعبة التي كانت والدتي تسردها وتتسامر بها مع الأقارب ، ويؤرخ لها الرجال في المجلس ، يروي كل واحد قصته الخاصة ، يسردها وأنا أصغي بكل جوارحي ، فرغم أنني تعلمت فن الإصغاء في المجلس إلا أنها قصص يسلب السرد فيها لبَّ المستمع ، كنت أعيش بخيالي الأحداث كأني أمارسها ، يحمل دخل الله العامري بندقية الصيد وينتخي عندما تقدمت الدبابات اليهودية نحو البلد ، قال له أبي : إلى أين يا دخل الله ببارودة الخرطوش أمام رتل الدبابات !! ، أجاب : " والله لأعطي الدار حقها " ، كان مع والدي- كما روى لي- رشاش استن ، قلت له : لماذا لم تحارب به ؟ ، قال : " حاربت ، حافظت على أمك وعماتك ومن لاذ بي من نساء البلد حتى أوصلتهن برّ الأمان ، أليس هذا عملاً بطوليا في زمن المجازر الجماعية ، لقد كان جدك علي هو العاقل الوحيد في البلد ، حَلَّ لفّة طربوشه البيضاء ، وربطها بعكازته ليسلم البلد وتسلم ، لكن أخوالك منعوه ، قالوا له أن اليهود قَتَلَة لا يقبلون بالتسليم ، إنهم يريدون الأرض بدون أهلها ، ارجع وإلا قتلوك ، أين تذهب بناتك إن تيتمن !؟ " ، عاد جدي ، ولاحقت الدبابات دخل الله العامري ، تابعوه ، كانوا يحصدون الفارين وكأنهم يكنسون البلد من أهلها ، رأوه يدخل مغارة ، أطلقوا الرشاشات داخلها ثم أخرجوا من فيها ، كان العدد هائلا ، مئات من المختبئين ، أطفال وعجائز، بنات ونساء ، آباء وأمهات ، وقليل من الشبان ، جعلوهم يصطفون صفوفا كأنهم في الصلاة ثم بدأت حفلة الموت .
روايات تفجر المخيلة ، لن يصدقها إلا من شاهدها ، وأنا صدقتها لأنني كنت مهروسا بين
أسنان السَّرد، انتقى عدد من الجنود أربع فتيات ، ربطوا أيديهن بالحبال ورموهن في دبابة ، أثارهم منظر امرأة تهدهد وليدها، دست ثديها في فمه، تقدم إليها أحد الجنود وانتزع الوليد بوحشية ، هاجمته أمه فأطلق عليها الآخر النار، ثم أمام الحشد رفع الجندي الطفل إلى الأعلى ثم رطمه بالأرض، لم يصرخ الطفل، لكن الجندي كفأه على وجهه وأحضر الآخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل ، لم يصرخ الطفل بينما تفجرت جمجمته ، والفتيات الأربع مربوطات على ظهر الدبابة ، كن ريفيات بأجساد قوية شرسة ، فكَّت إحداهن الحبال وقفزن من فوق الدبابة وبدأن بالهرب ، لكن الرشاشات أسرع منهن ، رشقنهن بصليات تقتل أربعين جملاً ، هكذا تروي والدتي ، قالت إنها نجت بأعجوبة قبل أن يجدها والدي ، كانت منكمشة وراء تلَّة تشاهد ، بدأ الناس يكبِّرون ، امرأة ثار عليها طلق الوضع ، اندفع جندي نحوها ، سَطَحَها بحربته ، غرز الحربة في جسد الوليد ثم سحبه وهو يتلعبط ، انتابت الجندي هستيريا الضحك ، ارتفع تكبير الناس ، تلاصق بعضهم وتدافع آخرون نحو الجنود ، لكن الجنود أطلقوا النار على الجميع ، أصوات الرشاشات هائلة لاحقت أيضا من حاول الإفلات ، ظلوا يطلقون الرصاص إلى أن تيقنوا أنهم قتلوا الجميع ، ظنوا ذلك ، ولكن ظل بعض من لم يلاحظ الجنود القتلة أن فيهم من كانت جراحه بسيطة، وأن في المغارة بعض الأطفال خبأتهم أمهم في مسفط الحوائج ، أم شاكر فريح استطاعت أن تختفي مع أولادها عن أعين اليهود في المغارة ، كي تروي مع أولادها شهادة المذبحة ، وسُمَيَّةُ ابنة دخل الله العامري الناجية الوحيدة من أفراد عائلتها ، أغمي عليها بين أكوام الجثث ، شاهِدُها الآن جرحها الذي تتحسسه كلما نظرت إلى المرآة ، كانت طفلة ، وهي الآن أم أبناء وبنات تروي لهم التفاصيل .
تفاصيل فظائع ضد البشرية ، تتكتم عليها الأمم المتحدة والآخرون رغم أن أدق تفاصيلها موثقة لديهم ، إنه خزي الحضارة الدموية . يصف أحد جنود الفرقة 89 في كتاب " الأسرار المذهلة للكارثة " شيئا من تفاصيل أخرى ضد الذين لم يغادروا بيوتهم في الدوايمة : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي ، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث ، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " ،
تفاصيل أخرى يرويها هذا الجندي الذي يَدَّعي أن ضميره أفاق فجأة ، وتوردها لجان التحقيق والقنصل الأمريكي في القدس ، ووزير الزراعة الإسرائيلي أهارون سيزلنغ ، لقد كان تقدير عدد القتلى ما بين سبعمائة إلى ألف ، قُتِلوا داخل البلد وعلى باب المغارة التي يسميها أهل الدوايمة ( مذبحة عراق الزاغ ) ، وفي مسجد البلدة ، ففي المسجد وحده قَتَلَ حنود الفرقة 89 أكثر من مئة وخمسين مُصَلٍّ ، لقد حدثت المذبحة أثناء صلاة يوم الجمعة ، الموافق 9/10/ 1948والناس منصرفون إلى مشاغلهم اليومية،والبلد مزدحمة باللاجئين إليها من أهالي القرى والمدن القريبة الذين نجوا من المذابح الأخرى ، إلاّ أن منهم أكثر ضحايا مذبحة الدوايمة.
يظل المخيم الشاهد الأهم على الكارثة ، ويبقي الفقر والفاقة والمرض ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة في المخيم ، أما الأرض السليبة وسيرة المذبحة فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم ، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة ، رغم أن كل ما في المخيم يرعف بها ، الشوارع ، الجدران ، المساءات ، ولعب الأولاد العنيف ، كانت ألعابنا لغة الحرب ، المبارزات والقتال والتهيئة الفطرية للثأر والعودة ، الحرب طائر العنقاء الذي ننتظره ، استدعيته في أشعاري الأولى ، أشعار تنضح بألوان الدم وأشجار الدوايمة وأريحا وسواد الموت والرؤى الناصعة النقية ، خلجات مفردات المخيم التي تشي بها أنفاس أبنائه ورياحين أجسادهم ، الأجساد التي لا تزيد عن أنها مشاريع قتلى وأسرى ، شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة ، تأتي أخبارهم أو جثثهم ، والمحظوظ منهم من لم يَمْحُ الرصاص تفاصيل جسده ، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام ، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيّا ، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة ، أعوام من الغياب ، يسرد للمهنئين وحشة الأسر والسجن ، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود ، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه ، وفلان تخلف في مغارة في البلد ، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص .
هكذا عين السلطان .. !! ، أنشودة الموت في المناطق المحرمة ، وصبر المغاور والسجون وزنازينها المظلمة ، وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة ، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر ، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة ، لا ماء لا إضاءة لا خدمات ، ليس إلا الفقر والفاقة والمرض ومغفر الشرطة والأونروى ، والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو .
أنه المخيم الذي أورثني مرارة الشعر وجمال لغتها، الدلالات والرموز وخصوبة التجربة، هذا المعين الذي أغرف منه الآن مضامين موغلة في الكثافة والتزاحم، منسوجة بخيوط الصور المركبة، المنثالة كأنها أمواج البحر المتلاطم، تستدعي ملاحين أشداء وسفن متمرسة في شَقِّ عباب العاصفة .
صور تتوالد من صور ، لا يجدي معها التصفيق ولا تستحثه ، كما لا تتوسل إلى المباشرة والخطابية، أو الرموز فقيرة الدلالات ، إنما هي صور تهيمن على المستمع وتنتزع منه دهشة الإنصات ولغة الصمت ، وفرد المخيلة على مداها وانفتاحها على آفاق جديدة مفعمة بالدلالات ،
تُحَوِّلُ الرمز إلى أسطورة على رأي الناقد الدكتور محمد صابرعبيد ، في وعاء من العبارات المشغولة بأفران جامعة دمشق، لقد انسكبت فيها أرواح أساتذة أجلاء عايشتهم في الجامعة، لهم أيد ماهرة بصياغة اللغة العربية السليمة بما يمكن أن نطلق عليه الكلاسيكية الجديدة، ومن ثم انسياق هذه الصياغة مع أساليب التعبير الشعري المعاصر، الذي اكتسبته من الإندماج بالساحة الثقافية بدمشق في تأججها الإبداعي، بحيث غادرت دمشق بينما كنت محسوبا على جيل النصف الأول من السبعينات في سوريا، الجيل الذي كرسته جريدة الثورة في عدد خاص بهم أوائل عام 1975 ، وكانوا ستة شعراء فقط .
لقد فتحت أمامي الساحة الشعرية في دمشق جغرافية الشعر الجديد، وجعلتني أنطلق عليها يكل حرية ، استفدت خلالها من الإحتكاك الشخصي بتجارب شعرائها الكبار، وبالتفاعل الصاخب مع أبناء جيلي فيها، لي حوارات عالية مؤثرة مع زملائي سليمان الأزرعي وعبد الله أبو هيف وحسين حموي والمرحوم نزار عدرا، وعبد الله غيث الذي توقعنا له مستقبلا نقديا باهرا ، لكنه اختفى ورسمي المدهون، وغيرهم . كما فتح الناقد الكبير خلدون الشمعة أمامي أهم المنابر الثقافية الدمشقية بحيث غادرت الجامعة أواخر عام 1975 شاعرا جاهزاً، حسب رأي الشاعر الكبير علي الجندي .
أعطيت نفسي كامل حريتي الإبداعية ، كنت متأججا ، أعتمد التجريب وتخطي الأنماط السائدة والمرفوض شعريا، فنشرت في عمان قصيدة النثر عام 1972، احتفى بها الدكتور إبراهيم خليل، مثلما كان خليل السواحري يحتفي بكتاباتي بشكل متميز .
أثرى تنوع أمكنة المناخات الثقافية العربية التي أعايش يومياتها حريتي الإبداعية ، مما جعل قصيدتي تتفاعل مع تلك الأمكنة ، وتسقط على حيثياتها دلالات خاصة بي ، لم يتناولها أحد بنفس اللغة التي شكلتها ، كما هو واضح في قصائد الخيل ، والبحر ، والجسد ، والجمر ، وغيرها ، وما تزال التجربة مستمرة مع ذلك التنوع المتوازي مع هجراتي المتعددة ، الأمر الذي يجعلني محتفيا بكل أنواع الشعر .
إنها النزعة الإبداعية المنفعلة أو لأقل المشوية مع ما ورثتها من الآتون الملتهب في أرض الشعر في أريحا ، الآتون الذي يدعى" عين السلطان" .
من خلال نزعة ابداعية تولدت من تنوع مناخات الأمكنة وما ورثته إنها النزعة الإبداعية المنفعلة أو لأقل المشوية مع ما ورثتها من الآتون الملتهب في أرض الشعر في أريحا ، الآتون الذي يدعى" عين السلطان" .
ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة ، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر ، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة ، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو، انه المخيم الذي أورثني مرارة الشعر وجمال لغته .
يالك من مخيم ، تتنفس جمالا برغم أنك تخوض في مرارة القهر ، وأن ساكنيك أبأس مظلومين في التاريخ البشري، جور انسل إليهم من عصور الغابات الأولى، هو أشدها وحشية، أنف أن يمارسه أي وحش من وحوش ما قبل التاريخ، فانسل الآن ومارسه عالم يهودي متوحش، يمتطي حضارة أوروبية متوحشة، أي وحشية أكثر قسوة ممن ينكر وجود إنسان حيا أمامه، هاهي الصليبية الجديدة تمحيك عن خارطة الحياة، وتكبت زفراتك زنازين لا حصر لها، وليس أمامك إلى أن تقاتل، وإذا كان لا بدّ من الموت، فلتقاتل لتحيا .
شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة، تأتي أخبارهم أو جثثهم، والمحظوظ منهم من لم يمح الرصاص تفاصيل جسده، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيا، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة، أعوام من الغياب، للمهنئين وحشة الأسر والسجن، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه، وفلان تخلف في مغارة في البلد، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص، وهكذا.، عين السلطان أنشودة الموت في المناطق المحرمة، أنشودة المغاور والسجون وزنازينها المظلمة، لكل إنسان فيه قصه ، حفظت منها ما سمعته من أصحابها، الطرد والاقتلاع وهدم البيوت والمجازر الجماعية، حدثني والدي عن مشاهداته لمذبحة الدوايمة وحدثتني والدتي عن نجاتها بالمصادفة ومشاهداتها الدامية للمذبحة قالت أن جنود الفرقة 19 من جنود وضباط عصابتي اشتيرن والهاجاناة كانوا يتسلون بقتل الأطفال أمام الناس، قصصا مفجعة روتها لي والدي ، ذكرت لي أسماء من شاهدتهم من الناس وكيف ذبحهم اليهود، قالت رأى أحدهم أما تدس ثديها في فم طفلها، ضحك اليهودي عاليا وانتزع الطفل من حضن أمه، رفعه بين يديه ورطمه بالأرض ثم كفأه على وجهه، أحضر جندي آخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل وصعد فوقه، وعندما هجمت أمه لتخلص طفلها أطلقوا عليها النار، وأمرأة أخرى حاملا بقر أحدهم بطنها بحربته وأخرج جنينها وهو انتابته نوبة ضحك هستيرية، قصة طويلة مرعبة يرويها الناجون من المذبحة، حتى أن أحد جنود الفرقة 89 التي ارتكبتها ادعى صحوة ضميره فقال : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي ، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث ، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
يظل المخيم الشاهد الأهم على المأساة، ويبقي الفقر والفاقة ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة في المخيم ، أما الأرض السليبة فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة، رغم أن كل ما في المخيم يشي بها حتى أنفاس أبنائه وروائه أجسادهم ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى، أسقف متلاصقة، وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر ، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو . أنه المخيم الذي أورثني مرارة اشعر وجمال لغته .
في المجلس ، يتحدثون عن محاولاتهم الحصول على السلاح للدفاع عن البلد فلم يجدوا من يبيع لهم ، اضطروا وأقصى ما استطاعوا الحصول عليه لا يزيد على أصابع الكفين، وما ذا تفيد، بنادق صيد وبنادق كحل وطبنجات، لعل والدي الوحيد الذي استطاع الحصول عل رشاش صغير له مهمة واحدة هي الدفاع عن أمي وعماتي ونساء العشيرة ومن يلوذ به من النساء، مهمة صعبة أمام دروع الهجاناة واشتيرن والقتلة من الكتيبة 89، ولكن لابد من ذلك ، استطاع أن ينجو بهن , أما الذين لم يستطيعوا فقد تحولوا إلى ضحايا لأفظع وأبشع مجازر القتل الجماعي في فلسطين ، حدث هذا في ظهيرة يوم الجمعة الموافق 9/10/1948 ،
حيث تقدر بعض لجان الأمم المتحدة ضحاياها حسبما ورد في كتاب " الأسرار المذهلة للكارثة الفلسطينية " تأليف مايكل بالومبو، ترجمة د. فهمي شما بأربعماية وخمسين، فقد ورد فيه على لسان أحد الشهود أن في مسجد القرية وحده قتل الجنود الإسرائيليون مئة وخمسين ،و يقدر القنصل الأمريكي في القدس وليم بيردت القتلى الآخرين في البلدة بثلاثمئة، فقد جاء في رسالته التي بعثها إلى واشنطن بخصوص هذه المذبحة" المراقبون غير قادرين على تحديد عدد الأشخاص المشمولين بتلك المذبحة وتختلف التقديرات بشكل كبير ، ولكن من المرجح أن يكون هنالك حوالي " ثلاثمائة عربي قد قتلوا في تلك البلدة ". ويقول وزير الزراعة الإسرائيلي في ذلك الوقت أهارون سيزلنغ في رسالة إلى أعضاء الحكومة الإسرائيلية : "لقد تصرف اليهود مثل النازيين وإن كياني يرتعش من جراء تلك الوحشية " ، وفي نفس الكتاب يصف أحد " جنود الفرقة 89 التي تتكون من إرهابيين سابقين من عصابتي الارجون واشتيرن بقوله : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب ، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
عصر لا مثيل له على وجه الأرض، تعلمنا منه ذوق الجمال فيل أن نعرفه، وعلمنا فطرة المحبة تلك التي نبتت في أحاسيسنا دون أن نفكر بها، كان العصر ممتلئا بالصبايا والثياب المطرزة، والغدف البيضاء كأنهن أسراب من الأوز الأبيض والملون .
يالك من مخيم ، تتنفس جمالا يرغم أنك تخوض في مرارة المجازر الجماعية، مجازر ينكرها الآخرون، الكل يدعي البراءة، مجزرة الدوايمة إحداها، ولكنها أكبرها عدداً، يقدر بعض المراجعين التاريخيين الإسرائيليين عدد ضحاياها بسبعماية بينما تقدرهم تقارير بعض لجان الأمم المتحدة بأربعماية وخمسين، بينما يقدرهم الناجون بأكثر من ذلك، لم تكن الضحايا من الدوايمة وحدها، وإنما أغلبهم من أبناء القرى والمدن القريبة، لجأوا إليها منذ أيام أو شهور ناجين بأنفسهم من الإبادة .
يا لك من مخيم، ساكنوك بقاياها، حالفهم الحظ فعاشوا، وأنا من مخلفات هذه البقايا، ولدت في المخيم، وصرت واحداً من ملامحه، شاهداً له وعليه ، مخيم ساكنوه ضحايا بريئة لأبأس جور في التاريخ البشري، جور انسل إليهم من عصور الغابات الأولى، هو أشدها وحشية ، أنف أن يمارسه أشد الوحوش الكاسرة عدوانية ولؤما وخسة من وحوش ما قبل التاريخ، فانسل الآن ومارسته وحوش يهودية، تمتطي حضارة أوروبية نهشت لحم عشرات الملايين من جرائها في حربين كونيتين لا مبررات مقنعة لهما إلا التعطش للدم ، إنه الوحش الكامن فيهم يولغ في دمائهم . أي قسوة أفظع خسة ولؤما ممن تجلس معه على نفس الطاولة ثم يخاطبك أنه لا يراك ، يرى كل شيء حوله ، الطاولة والكرسي وكأس الشاي لكنه لا يراك ، ينكرك وينكرك إرضاء له أكلة لحوم أبنائهم رغم أنهم يرونك ويحسون بك ويصرون أنك خرافة، هاهي الصليبية الجديدة تمحيك عن خارطة الحياة، وتكبت زفراتك زنازين لا حصر لها، وليس أمامك إلى أن تقاتل، وإذا كان لا بدّ من الموت فلتقاتل لتحيا .
شباب يتساقطون في المنطقة الحرام على خط الهدنة ، تأتي أخبارهم أو جثثهم ، والمحظوظ منهم من لم يمح الرصاص تفاصيل جسده ، كم شاب عاد كهلا بعد أعوام ، يدلف باب أهله ليلا فيتفاجأون به حيا، يفرحون ويفرح الجيران والمخيم وتنبض الشوارع المجاورة بالحياة ، أعوام من الغياب، يسرد للمهنئين وحشة الأسر والسجن ، ومحاولات الفرار وتهريب الأسرى من سجون اليهود ، فلان انقتل وهو يتبادل البندقية مع رفيقه ، وفلان تخلف في مغارة في البلد، وفلان لا يزال يترقب في السجن فرصة الخلاص ، وهكذا..، عين السلطان أنشودة الموت في المناطق المحرمة، أنشودة المغاور والسجون وزنازينها المظلمة، ينكره سواه ولكنه يصرّ على إعلان وجوده .
لكل إنسان فيه قصه، حفظت منها ما سمعته من أصحابها ، الطرد والاقتلاع وهدم البيوت والمجازر الجماعية، حدثني والدي عن مشاهداته لمذبحة الدوايمة وحدثتني والدتي عن نجاتها بالمصادفة ومشاهداتها الدامية للمذبحة قالت أن جنود الفرقة 89 من جنود وضباط عصابتي اشتيرن والهاجاناة كانوا يتسلون بقتل الأطفال أمام الناس ، قصصا مفجعة روتها لي، ذكرت أسماء من شاهدتهم وكيف ذبحهم اليهود ، قالت رأى أحد الجنود أما تدس ثديها في فم طفلها ، ضحك اليهودي عاليا وانتزع الطفل من حضن أمه ، رفعه بين يديه ورطمه بالأرض ثم كفأه على وجهه ، أحضر جندي آخر حجراً كبيراً وضعه على رأس الطفل وصعد فوقه، وعندما هجمت أمه عليه أطلقوا عليها النار، وامرأة أخرى كانت حاملا بقر أحدهم بطنها بحربته، أخرج جنينها فانتابته نوبة ضحك هستيرية، قصص طويلة مرعبة يرويها الناجون من المذبحة، حتى أن أحد جنود الفرقة 89 تلك ،ادعى - متأخراً - صحوة ضميره فقال : " لقد قتلوا الأطفال بتحطيم رؤوسهم بالعصي، ولم يكن هنالك بيت واحد يخلوا من الجثث، ثم قادوا النساء والرجال إلى بيوت أخرى تاركين إياهم بدون طعام أو شراب، وبعدئذ فجروا هذه البيوت على من فيها من مدنيين لا حول لهم ولا قوة " .
يظل المخيم الشاهد الأهم على المأساة، ويبقي الفقر والفاقة ومركز الشرطة والأونروى وهيئة إغاثة اللاجئين أصحاب السطوة فيه، أما الأرض السليبة القرى والمدن، البساتبن والكروم، الزروع والمحلات التجارية والمضارب، الدروب والطرقات والحارات، الليالي المقمرة وشموس الصباحات، والمساءات المفعمة بالمسرات، فهي المخبأة في تلافيف العظم واللحم، إنها الجوهرة المخفية بحرص شديد عن العيون المريبة، رغم أن كل ما في المخيم يشي بها حتى أنفاس أبنائه وروائه أجسادهم ورفيف أرواحهم واضح جداً في فضاءاته .
وفضاءاته بيوت طينية على المدى ، أسقف متلاصقة وحيطان متراصة كقطيع خراف تحت المطر، شوارع ترابية يتعثر بحجارتها وحفرها المارة، لاما لا إضاءة لا خدمات، لا أدنى الخدمات، ليس إلا الفقر والفاقة ومخفر الشرطة والأونروى والجثث شبه اليومية التي تأتي بدمها الأخضر، والعائدون من ذاكرة الفقدان في سجون العدو .أنه المخيم الذي أورثني مرارة اشعر وجمال لغته .
في المجلس، يتحدثون عن محاولاتهم الحصول على السلاح للدفاع عن البلد لم يجدوا من يبيع لهم، اضطروا وأقصى ما استطاعوا الحصول عليه لا يزيد على أصابع الكفين، وما ذا تفيد، بنادق صيد وبنادق كحل وطبنجات، لعل والدي الوحيد الذي استطاع الحصول عل رشاش صغير له مهمة واحدة هي الدفاع عن أمي وعماتي وعرض العشيرة ومن يلوذ به من النساء، مهمة صعبة أمام دروع ا?