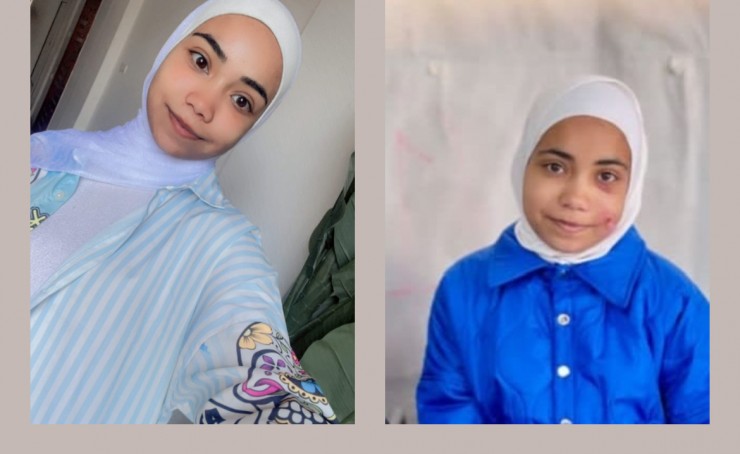جمالية الحذف في قصيدة وردة لذات النونين للشاعر محمد عبد الباري
بي دي ان |
04 سبتمبر 2022 الساعة
04:34م

مهدي رمضان شعبان
إن ظاهرة الحذف ظاهرة لسانية اجتماعية نفسية؛ لأنها تشترك فيها اللغات البشرية كافة، وإن تعريفها لغة جاء في المعجم الوسيط " حذف الشيء حذفا: قطعه من طرفه. يقال حذف الحجام الشعر: أسقطه( )".
إن الحذف ظاهرة لسانية تطرق لها علماء النحو، والبلاغة، وكذلك اللسانيون، وعلماء النقد الحديث، وعلماء اللغة. فهو قطع أو استبعاد بعض كلام المتكلم، إن الحذف لا يكون إلا إذا كان المخاطَبُ عالماً به، ومفهوماً من خلال المقام الذي قيل فيه الكلام فإن المتحدث يتطرق إلى حذف الشيء الواضح الجلي، والأقوال المضمرة هي الأقوال التي يحذفها المتكلم، لأغراض عدة، وهذا الغرض هو قصد المتكلم.
فعلماء النحو عند تقديرهم للمحذوفات خلصوا إلى أن الحذف لا يكون إلا بدليل وافتراض مسبق يكون عند كل من المتكلم والمتلقي: ومن هؤلاء العلماء المبرد، حيث قال: " لم يجز حذف الْفِعْل إِلَّا وَعَلِيهِ دَلِيل نَحْو: زيدا لَو قلت ذَلِك لم يدر مَا الْفِعْل الْمَحْذُوف؟ فَإِن رَأَيْت رجلا أَشَارَ بِسيف فَقلت: زيدا أَو ذكرت أَنه يضْرب أَو نَحْو ذَلِك جَازَ؛ لِأَن الْمَعْنى: أوقع ضربك بزيد"، فهو هنا يؤكد على الافتراض المسبق والأقوال المضمرة في الخطاب؛ حيث نلاحظ أن الافتراض المسبق عندما قال المتكلم: زيدا، فهو يفترض أن أحداً يريد ضرب زيد أو قتله.
والنحاة يستنبطون المحذوف، من خلال سياق النص والموقف والظرف الذي قيل فيه الكلام، فيعرفون غرض المتكلم، فإن قيل لأحد، ماذا صنعت؟ فأجاب: خيرا، فهنا حذف الفعل، لوجوده في السؤال؛ فالمجيب يركز على المفعول بقوله خيرا، فغرضه التخصيص؛ لأنه خصص الخير دون غيره، وإن كان استنباطهم عبارة عن إشارات دلالية واضحة تؤكد أن عملهم في مجمله لم يصرف النظر عن هذا المنحى بشكل أو بآخر، سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد( )، لكنهم في دراساتهم "لم ينصوا على أن المنحى الاجتماعي مبدأ من مبادئ التقعيد أو أصل من الأصول اللغوية، بل إنهم نظروا في تراثهم اللغوي على أنه ضرب من النشاط الإنساني الذي يتفاعل هو ومحيطه وأحواله، مع مراعاة تغير صوره تبعا لتغير محيطه وأحواله( )"، وإن أحد المحدثين عَده أصلاً من أصول نظريتهم، حيث قال: "نعدُ هذا الملمح الاجتماعي أصلا يضاف إلى أصول نظرية النحاة العرب، فإنه أصل مستأنس لديهم باطراد مستشعر في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدر عنهم، وإن لم يصرحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعية( )" والتداولية وغيرهم.
ومن أنواع الحذف: حذف حرف، وكلمة، وجملة، وأكثر من جملة.
وإن عبد الباري وظف حذف أكثر من جملة فتجلى الحذف في أبهى صورة في القصيدة الغزلية القصيرة، والتي وضعها في صفحة منفردة رغم صغرها، حيث قال في قصيدة وردة لذات النونين:
نون. . .ونون
ثم تقترب السماوات البعيدة
.
.
.
.
.
إني رأيت الليل
قدم كل أوراق اللجوء
لشامة امرأة وحيدة
من أصعب التقديرات المحذوفة في شعر محمد عبد الباري ما وجده الباحث في قصيدته السابقة، لأنه فتح المجال للتأويل دون إشارات واضحة على ماهية المحذوف من الجمل، فيستطيع كل باحث أن يؤول المحذوف حسب وجهة نظره، إلا أن الباحث استنبط المعنى المحذوف وفق قراءة تداولية قام بها الباحث في شعر محمد عبد الباري، فتوصل إن الشاعر في هذه القصيدة يظهر غزله العفيف، وهذا يدل على أنه يتمتع بفطرة سليمة، فهو يستعمل الحذف فإن الحذف يظهر في عنوان القصيدة، والتقدير يكون على وجهين، الأول تقدير فعل محذوف، فيكون العنوان: أقدم وردة لذات النونين، والثاني تقدير اسم محذوف، فيكون العنوان: حياتي وردة لذات النونين، فهنا تظهر بلاغة الشاعر في الحذف، فقد حذف ليركز على الوردة الموجودة في ذات النونين.
ولقد اتبع الشاعر الحكاية في قصيدته ليشوق الجمهور، فأشار إلى محبوبته بصفة صاحبة النونين، وكانت إشارة رمزية بينه وبين نفسه حتى يستلهم القارئ ويحيره بشوق لمعرفة هذا الجمال الخفي، فوصف حضورها كأنه جمال سماوي بعيد المنال قد اقترب، ويطول الحديث بالبوح عن هذا الجمال، ولا ينتهي، فيترك للقارئ تخيل كل ما لا يتصف.
وشبهها بالسموات العليا البعيدة، فهو يحلم بها كل ليلة، فالذي يفكر في شخص ينظر إلى السماء، وعندما يتخيلها في السماء، تقترب منه، ثم حذف ما حصل بينهما بعدما اقتربت، وكان الحذف والاختصار في الأبيات دليلا على مراوغة الشاعر، فيتضح أن محمد عبد الباري استخدام هذا الأسلوب في توجيه لنا الفكرة بإبداع، ووضوح في إيجاز دون أن يضع القارئ في فجوة أو غموض، ويقطع خيال القارئ فيقول له أن الليل بنفسه خضع لهذه الحسناء، وتخلى عن كبريائه، عندما تمثل أمام شامتها الحسناء، فوجد أن سوادها أجمل من سواده، فقد انتهى أمام شام امرأة وحيدة دون سائر النساء. والشاعر يؤكد أن ليل المحبين والعشاق يستسلم أمام شامة في خد المحبوبة، فإذا كان الشيء البسيط يجذبه فما بال باقي المفاتن!.
[email protected]
بي دي ان |
04 سبتمبر 2022 الساعة 04:34م

مهدي رمضان شعبان
إن الحذف ظاهرة لسانية تطرق لها علماء النحو، والبلاغة، وكذلك اللسانيون، وعلماء النقد الحديث، وعلماء اللغة. فهو قطع أو استبعاد بعض كلام المتكلم، إن الحذف لا يكون إلا إذا كان المخاطَبُ عالماً به، ومفهوماً من خلال المقام الذي قيل فيه الكلام فإن المتحدث يتطرق إلى حذف الشيء الواضح الجلي، والأقوال المضمرة هي الأقوال التي يحذفها المتكلم، لأغراض عدة، وهذا الغرض هو قصد المتكلم.
فعلماء النحو عند تقديرهم للمحذوفات خلصوا إلى أن الحذف لا يكون إلا بدليل وافتراض مسبق يكون عند كل من المتكلم والمتلقي: ومن هؤلاء العلماء المبرد، حيث قال: " لم يجز حذف الْفِعْل إِلَّا وَعَلِيهِ دَلِيل نَحْو: زيدا لَو قلت ذَلِك لم يدر مَا الْفِعْل الْمَحْذُوف؟ فَإِن رَأَيْت رجلا أَشَارَ بِسيف فَقلت: زيدا أَو ذكرت أَنه يضْرب أَو نَحْو ذَلِك جَازَ؛ لِأَن الْمَعْنى: أوقع ضربك بزيد"، فهو هنا يؤكد على الافتراض المسبق والأقوال المضمرة في الخطاب؛ حيث نلاحظ أن الافتراض المسبق عندما قال المتكلم: زيدا، فهو يفترض أن أحداً يريد ضرب زيد أو قتله.
والنحاة يستنبطون المحذوف، من خلال سياق النص والموقف والظرف الذي قيل فيه الكلام، فيعرفون غرض المتكلم، فإن قيل لأحد، ماذا صنعت؟ فأجاب: خيرا، فهنا حذف الفعل، لوجوده في السؤال؛ فالمجيب يركز على المفعول بقوله خيرا، فغرضه التخصيص؛ لأنه خصص الخير دون غيره، وإن كان استنباطهم عبارة عن إشارات دلالية واضحة تؤكد أن عملهم في مجمله لم يصرف النظر عن هذا المنحى بشكل أو بآخر، سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد( )، لكنهم في دراساتهم "لم ينصوا على أن المنحى الاجتماعي مبدأ من مبادئ التقعيد أو أصل من الأصول اللغوية، بل إنهم نظروا في تراثهم اللغوي على أنه ضرب من النشاط الإنساني الذي يتفاعل هو ومحيطه وأحواله، مع مراعاة تغير صوره تبعا لتغير محيطه وأحواله( )"، وإن أحد المحدثين عَده أصلاً من أصول نظريتهم، حيث قال: "نعدُ هذا الملمح الاجتماعي أصلا يضاف إلى أصول نظرية النحاة العرب، فإنه أصل مستأنس لديهم باطراد مستشعر في تحليلاتهم على نحو يمثل استخراجه إحياء لأصل من أصولهم صدر عنهم، وإن لم يصرحوا به تصريح اللسانيات الاجتماعية( )" والتداولية وغيرهم.
ومن أنواع الحذف: حذف حرف، وكلمة، وجملة، وأكثر من جملة.
وإن عبد الباري وظف حذف أكثر من جملة فتجلى الحذف في أبهى صورة في القصيدة الغزلية القصيرة، والتي وضعها في صفحة منفردة رغم صغرها، حيث قال في قصيدة وردة لذات النونين:
نون. . .ونون
ثم تقترب السماوات البعيدة
.
.
.
.
.
إني رأيت الليل
قدم كل أوراق اللجوء
لشامة امرأة وحيدة
من أصعب التقديرات المحذوفة في شعر محمد عبد الباري ما وجده الباحث في قصيدته السابقة، لأنه فتح المجال للتأويل دون إشارات واضحة على ماهية المحذوف من الجمل، فيستطيع كل باحث أن يؤول المحذوف حسب وجهة نظره، إلا أن الباحث استنبط المعنى المحذوف وفق قراءة تداولية قام بها الباحث في شعر محمد عبد الباري، فتوصل إن الشاعر في هذه القصيدة يظهر غزله العفيف، وهذا يدل على أنه يتمتع بفطرة سليمة، فهو يستعمل الحذف فإن الحذف يظهر في عنوان القصيدة، والتقدير يكون على وجهين، الأول تقدير فعل محذوف، فيكون العنوان: أقدم وردة لذات النونين، والثاني تقدير اسم محذوف، فيكون العنوان: حياتي وردة لذات النونين، فهنا تظهر بلاغة الشاعر في الحذف، فقد حذف ليركز على الوردة الموجودة في ذات النونين.
ولقد اتبع الشاعر الحكاية في قصيدته ليشوق الجمهور، فأشار إلى محبوبته بصفة صاحبة النونين، وكانت إشارة رمزية بينه وبين نفسه حتى يستلهم القارئ ويحيره بشوق لمعرفة هذا الجمال الخفي، فوصف حضورها كأنه جمال سماوي بعيد المنال قد اقترب، ويطول الحديث بالبوح عن هذا الجمال، ولا ينتهي، فيترك للقارئ تخيل كل ما لا يتصف.
وشبهها بالسموات العليا البعيدة، فهو يحلم بها كل ليلة، فالذي يفكر في شخص ينظر إلى السماء، وعندما يتخيلها في السماء، تقترب منه، ثم حذف ما حصل بينهما بعدما اقتربت، وكان الحذف والاختصار في الأبيات دليلا على مراوغة الشاعر، فيتضح أن محمد عبد الباري استخدام هذا الأسلوب في توجيه لنا الفكرة بإبداع، ووضوح في إيجاز دون أن يضع القارئ في فجوة أو غموض، ويقطع خيال القارئ فيقول له أن الليل بنفسه خضع لهذه الحسناء، وتخلى عن كبريائه، عندما تمثل أمام شامتها الحسناء، فوجد أن سوادها أجمل من سواده، فقد انتهى أمام شام امرأة وحيدة دون سائر النساء. والشاعر يؤكد أن ليل المحبين والعشاق يستسلم أمام شامة في خد المحبوبة، فإذا كان الشيء البسيط يجذبه فما بال باقي المفاتن!.
[email protected]