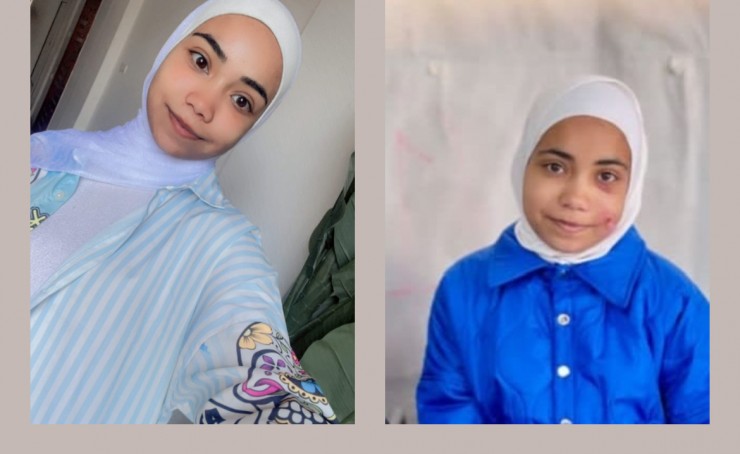مؤتمر الدراسات المستقبلية
بي دي ان |
30 مارس 2022 الساعة
09:05م
 عقد يوم الاحد الماضي الموافق 27 مارس الحالي في احدى قاعات فندق الكرمل بمدينة رام الله مؤتمرا نوعيا وهاما بعنوان "دراسات مستقبلية في الامن والاقتصاد والمتغيرات العربية والعالمية" نظمه كل من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، وكان لي نصيب التعقيب على الورقة النظرية الأساس للدكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس، وهي بعنوان "الدراسات المستقبلية تعريفاتها واساليبها واستخداماتها"، والتي تضمنت رؤيته للدراسات المستقبلية، وتبنى فيها الاتجاه الداعم لاعتبارها "علما مستقلا"، وقدم اسانيده العلمية بالعودة لاصحاب هذا الاتجاه من المختصين في الدراسات المستقبلية.
عقد يوم الاحد الماضي الموافق 27 مارس الحالي في احدى قاعات فندق الكرمل بمدينة رام الله مؤتمرا نوعيا وهاما بعنوان "دراسات مستقبلية في الامن والاقتصاد والمتغيرات العربية والعالمية" نظمه كل من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، وكان لي نصيب التعقيب على الورقة النظرية الأساس للدكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس، وهي بعنوان "الدراسات المستقبلية تعريفاتها واساليبها واستخداماتها"، والتي تضمنت رؤيته للدراسات المستقبلية، وتبنى فيها الاتجاه الداعم لاعتبارها "علما مستقلا"، وقدم اسانيده العلمية بالعودة لاصحاب هذا الاتجاه من المختصين في الدراسات المستقبلية.
ورغم تقديري للجهد النظري المبذول من قبله في ورقة العمل التي عرضها في المؤتمر، غير اني اعتقد ان الإقرار بوجود "علم المستقبل"، هو إقرار اشكالي، لان إسباغ صفة العلم على الدراسات المستقبلية فيها خروج عن المألوف في تصنيف العلوم. لا سيما وان العلوم المختلفة بدءا من علوم الفلسفة والفلك والتاريخ والجغرافيا والسياسة والعلوم الطبيعية بمختلف مسمياتها وصولا لعلم الاي تي تختلف عن ما يسمى ب"علم المستقبل"، لان كافة العلوم الأخرى لها ركائز في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والجغرافي والبيولوجي والتكنولوجي، بيد ان ما يسمى "علم المستقبل"، هو علم افتراضي، استشرافي، حدسي، لا أساس له في الواقع، والدليل من الأسئلة المتصلة بمشروع العلم التي اثارها كل من تطرق له بدءا من المؤسس "جيلفيلان" الأميركي عام 1920، وانتهاءا بالدكتور احمد رفيق عوض، الذي أعاد اثارة ذات الأسئلة، ومنها : ما الذي يمكن، او يحتمل، او ينبغي ان يحدث في زمان مستقبلي محدد بعد عقد او عقدين او اكثر؟ في حين أسئلة الحاضر تكون: ماذا يحدث الان؟ ولماذا؟ اما دراسات الماضي فتكون: ماذا حدث؟ ولماذا؟
وهذه الأسئلة بحد ذاتها تظهر احد جوانب الإشكالية في ما يسمى "علم المستقبل"، لانه لا يقوم على أسس واضحة المعالم، وانما يعتمد على الفرضيات البعيدة عن اليقين، ويمكن ان تصيب أو تخطىء، ولهذا تلجأ الدول والشركات والمؤسسات لوضع مجموعة من الطرق مثل طريقة "دلفي" لتحقيق هذا الهدف او ذاك. مع ذلك تجدر الإشارة إلى ان الطريقة المذكورة انفا اشكالية في اسمها ونتائجها، واما اسمها فيعود لاسم رجل من الأساطير الاغريقية، ويدعى اراكل من منطقة دلفي، رجل تنبؤات وليس استشرافات (وتم اختيار اسم الطريقة عام 1944 من قبل البحرية الأميركية) مما دعى العديد من الباحثين والعلماء للاعتراض على اختيار الاسم. لان الدراسات المستقبلية لا يربطها رابط بالتنجيم والسحر والتنبؤات، والا كان علينا ان نستخدم طريقة "نوستراداموس" او الجدة البلغارية "فانغا" ألخ. اضف إلى ان طريقة "دلفي" عانت من نقاط ضعف عديدة، واوردها عوض في مداخلته، مما دفع المعتمدين عليها لتطويرها لتفادي النواقص، ومازالت تخضع للمراجعة والتطوير.
وعلى اهمية اعتماد هذه الظاهرة التاريخية جملة من السيناريوهات الافتراضية في استشرافها المستقبل، والتي اقتبسها عوض ممن سبقوه لتحقيق الغاية المرجوة سياسيا او اقتصاديا او عسكريا او اجتماعيا او تكنولوجيا. يكشف عنصر خلل أساسي في الإقرار بوجود "علم المستقبل". لان وضع السيناريوهات بحد ذاته يشير إلى تعميق نقطة الضغف المركزية في إضفاء صبغة العلم على الدراسات المستقبلية. لان السيناريوهات المختلفة ان كانت 2 او 4 او اكثر قد تحتاج في سياق تحقيق غاية ما إلى تطوير، وإعادة نظر في ادواتها والامكانيات والنفقات والزمن الذي تحتاجه لبلوغها، وكون العلم يقوم على ركائز علمية محددة وواضحة وناظمة لتطوره، لا يعتمد ابدا على السيناريوهات الافتراضية. ولكن كل العلوم مفتوحة الافاق امام فضاء التطور المعرفي ارتباطا بتطور قوى وعلاقات الإنتاج في المجتمع البشري ككل.
وعليه فانني اميل لاعتماد وجهة نظر الأغلبية العظمى من علماء الدراسات المستقبلية، وخاصة عالم المستقبليات المغربي العربي، المهدي المنجرة، والدكتور احمد صدقي الدجاني الفلسطيني العربي والعالم الهولندي فريد بولاك، الذي انتقد استخدام مصطلح "علم المستقبل"، لان المستقبل مجهول، فكيف نرسي علما للمجهول؟ وهم وغيرهم من الخبراء والرواد في هذا الحقل يعتقدون ان الدرسات المستقبلية لا تعدو اكثر من ظاهرة من ظواهر التاريخ، وهي ظاهرة ضرورية جدا لاستشراف المستقبل. وبالتالي الاختلاف ليس على أهمية الظاهرة وضرورتها للانسان والمجتمعات البشرية في التطور، وانما في تصنيفها ك"علم".
وهذه الظاهرة الهامة تعتمد على الماضي والحاضر لاستشراف المستقبل. وبالتالي مطلوب التعامل معها، وتعزيزها وتطويرها، من خلال الاهتمام بها، وتخصيص مراكز بحثية للانكباب على استشراف المستقبل، ووضع صناع القرار امام استخلاصات الخبراء والمختصون وسيناريوهاتهم المختلفة للاستفادة منها في رسم الاستراتيجيات، وتعميق الخطط ذات الابعاد المتعددة لتطوير المجتمعات والامن الوطني والقومي والإنساني والحد من الاثار السلبية.
وحول التباين في وجهات النظر بيني وبين الدكتور عوض، عقب الدكتور عبد الرحمن التميمي في مداخلته داعما وجهة نظر الدكتور احمد، قائلا ان هناك اكثر من 150 جامعة تعتمد الدراسات المستقبلية ك"علم"، وتناسى ان عدد الجامعات في العالم حسب هيئة تقييم الجامعات الدولية في العالم بلغ حتى بداية عام 2011 ( 17716) جامعة ومعهد عالي يوجد منها ما يزيد عن 7000 في أمريكا الشمالية (خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا). وبالتالي برهان التميمي لا يعتبر سندا في الدفاع عن وجهة النظر، التي تبنها عوض وقطاع من الأساتذة الافاضل في الجامعات المذكورة.
وكما ذكرت هذه الظاهرة ليست جديدة، ولم تنشأ عام 1907 او 1920، وانما كانت سابقة على ذلك التاريخ. وان لم تأخذ هذه الصفة في الازمان الغابرة والسابقة، بيد انها صفة ملاصقة للانسان كفرد ومجتمع في تطوره. لكن عدم تسليط الضوء عليها يعود لاسباب تتعلق بتطور المجتمعات البشرية. جميعنا يعلم ان العلماء في الحقب التاريخية الغابرة كانوا يتميزون بسمة جمع العديد من العلوم في دراساتهم وكتاباتهم، وقدموا اسهامات غاية في الأهمية في الفلسفة والفلك والطب والاحياء والرياضيات، وكان لديهم استشرافاتهم المستقبلية في واقعهم المحدد، وعلى مستويات إقليمية ودولية وفق معايير تلك الازمنة ... إلخ ولكن لم يتم التعامل معها كظاهرة علمية.
واشرت في تعقيبي لموضوع الاستشراف للمستقبل واهميته، وأوردت 3 نماذج بشكل سريع، منها نموذج استشراف هرتزل الصهيوني عن إقامة الدولة الإسرائيلية بعد خمسين عاما في عام 1897، ويعتبر هذا من النماذج الحدسية، او كما عرفه المختصون "النموذج البديهي". ونموذج ثاني قدمه كارل ماركس، الذي استشرف وصول المجتمع البشري إلى المرحلة الاشتراكية استنادا لقراءة التطور التاريخي "المادية التاريخية" بالعلاقة مع "المادية الديالكتيكية" من خلال اعتماد "النموذج الاستكشافي"، كما جاء في الدراسة؛ والنموذج الثالث ما قدمتة دراسات الدكتور حامد ربيع عن "استشراف مستقبل الإسلام بين القوى الدولية خلال القرن الحادي والعشرين" انطلاقا من سؤال "هل يستطيع الإسلام ان يرتفع إلى مصاف القوى الدولية؟ باعتماده النموذج "الاستهدافي او المعياري" وحتى نموذج "التغذية العكسية" وفق ما تضمنته الدراسة مثار النقاش.
باختصار وحتى لا اطيل، تسليط الضوء على الدراسات المستقبلية، والاهتمام بها واغنائها، وترسيخها في استشراف المستقبل في ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية العسكرية والتكنولوجية وبالضرورة السياسية بات ضرورة للمجتمعات وصناع القرار فيها.
واتفق مع ما تضمنته الدراسة بشأن عوامل الضعف في الوطن العربي، وتغييبها هذه الظاهرة، وعدم ايلائها الاهتمام المطلوب، حتى ان اربعة أبحاث من سبعة حول قضايا العالم العربي ومصر وسوريا مولتها الأمم المتحدة، وهو ما يكشف عن خلل كبيرة في أوساط صناع القرار العرب، ليس هذا فحسب، بل انها لم تحاول ان تسهم في تمويل هكذا دراسات، ولم تعر الاهتمام الكافي لانشاء وتطوير مراكز أبحاث خاصة بدراسات المستقبل. الامر الذي يفرض على الأنظمة التي تدعي انها ديمقراطية ان تعمل على الاتي: أولا انشاء مراكز ومؤسسات بحثية خاصة بدراسة المستقبليات؛ ثانيا تأمين حرية الرأي والرأي الاخر للوصول للاستنتاجات والاستشرافات المستقبلية؛ ثالثا تأمين التمويل المطلوب لها؛ رابعا تأمين الوصول للمعلومات بحرية ودون قيود لبلوغ الهدف المرجو منها ... إلخ
ظاهرة الدراسات المستقبلية اكثر من مهمة للشعب العربي الفلسطيني، واحوج ما يكون لها هو صانع القرار الفلسطيني، الذي تملي عليه مصالحه وحساباته واستقراءه للمستقبل إيلاء الاهتمام اكثر فاكثر لتأسيس وانشاء المراكز البحثية المختصة بالدراسات المستقبلية، وتقديم كل عوامل النجاح والتطور لها. وبالمحصلة لا املك سوى تقديم الشكر لمركزي الدراسات الفلسطينيين وللقائمين عليها لايلائهما الدراسات المستقبلية الأهمية التي تستحق.
[email protected]
[email protected]
بي دي ان |
30 مارس 2022 الساعة 09:05م

ورغم تقديري للجهد النظري المبذول من قبله في ورقة العمل التي عرضها في المؤتمر، غير اني اعتقد ان الإقرار بوجود "علم المستقبل"، هو إقرار اشكالي، لان إسباغ صفة العلم على الدراسات المستقبلية فيها خروج عن المألوف في تصنيف العلوم. لا سيما وان العلوم المختلفة بدءا من علوم الفلسفة والفلك والتاريخ والجغرافيا والسياسة والعلوم الطبيعية بمختلف مسمياتها وصولا لعلم الاي تي تختلف عن ما يسمى ب"علم المستقبل"، لان كافة العلوم الأخرى لها ركائز في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والجغرافي والبيولوجي والتكنولوجي، بيد ان ما يسمى "علم المستقبل"، هو علم افتراضي، استشرافي، حدسي، لا أساس له في الواقع، والدليل من الأسئلة المتصلة بمشروع العلم التي اثارها كل من تطرق له بدءا من المؤسس "جيلفيلان" الأميركي عام 1920، وانتهاءا بالدكتور احمد رفيق عوض، الذي أعاد اثارة ذات الأسئلة، ومنها : ما الذي يمكن، او يحتمل، او ينبغي ان يحدث في زمان مستقبلي محدد بعد عقد او عقدين او اكثر؟ في حين أسئلة الحاضر تكون: ماذا يحدث الان؟ ولماذا؟ اما دراسات الماضي فتكون: ماذا حدث؟ ولماذا؟
وهذه الأسئلة بحد ذاتها تظهر احد جوانب الإشكالية في ما يسمى "علم المستقبل"، لانه لا يقوم على أسس واضحة المعالم، وانما يعتمد على الفرضيات البعيدة عن اليقين، ويمكن ان تصيب أو تخطىء، ولهذا تلجأ الدول والشركات والمؤسسات لوضع مجموعة من الطرق مثل طريقة "دلفي" لتحقيق هذا الهدف او ذاك. مع ذلك تجدر الإشارة إلى ان الطريقة المذكورة انفا اشكالية في اسمها ونتائجها، واما اسمها فيعود لاسم رجل من الأساطير الاغريقية، ويدعى اراكل من منطقة دلفي، رجل تنبؤات وليس استشرافات (وتم اختيار اسم الطريقة عام 1944 من قبل البحرية الأميركية) مما دعى العديد من الباحثين والعلماء للاعتراض على اختيار الاسم. لان الدراسات المستقبلية لا يربطها رابط بالتنجيم والسحر والتنبؤات، والا كان علينا ان نستخدم طريقة "نوستراداموس" او الجدة البلغارية "فانغا" ألخ. اضف إلى ان طريقة "دلفي" عانت من نقاط ضعف عديدة، واوردها عوض في مداخلته، مما دفع المعتمدين عليها لتطويرها لتفادي النواقص، ومازالت تخضع للمراجعة والتطوير.
وعلى اهمية اعتماد هذه الظاهرة التاريخية جملة من السيناريوهات الافتراضية في استشرافها المستقبل، والتي اقتبسها عوض ممن سبقوه لتحقيق الغاية المرجوة سياسيا او اقتصاديا او عسكريا او اجتماعيا او تكنولوجيا. يكشف عنصر خلل أساسي في الإقرار بوجود "علم المستقبل". لان وضع السيناريوهات بحد ذاته يشير إلى تعميق نقطة الضغف المركزية في إضفاء صبغة العلم على الدراسات المستقبلية. لان السيناريوهات المختلفة ان كانت 2 او 4 او اكثر قد تحتاج في سياق تحقيق غاية ما إلى تطوير، وإعادة نظر في ادواتها والامكانيات والنفقات والزمن الذي تحتاجه لبلوغها، وكون العلم يقوم على ركائز علمية محددة وواضحة وناظمة لتطوره، لا يعتمد ابدا على السيناريوهات الافتراضية. ولكن كل العلوم مفتوحة الافاق امام فضاء التطور المعرفي ارتباطا بتطور قوى وعلاقات الإنتاج في المجتمع البشري ككل.
وعليه فانني اميل لاعتماد وجهة نظر الأغلبية العظمى من علماء الدراسات المستقبلية، وخاصة عالم المستقبليات المغربي العربي، المهدي المنجرة، والدكتور احمد صدقي الدجاني الفلسطيني العربي والعالم الهولندي فريد بولاك، الذي انتقد استخدام مصطلح "علم المستقبل"، لان المستقبل مجهول، فكيف نرسي علما للمجهول؟ وهم وغيرهم من الخبراء والرواد في هذا الحقل يعتقدون ان الدرسات المستقبلية لا تعدو اكثر من ظاهرة من ظواهر التاريخ، وهي ظاهرة ضرورية جدا لاستشراف المستقبل. وبالتالي الاختلاف ليس على أهمية الظاهرة وضرورتها للانسان والمجتمعات البشرية في التطور، وانما في تصنيفها ك"علم".
وهذه الظاهرة الهامة تعتمد على الماضي والحاضر لاستشراف المستقبل. وبالتالي مطلوب التعامل معها، وتعزيزها وتطويرها، من خلال الاهتمام بها، وتخصيص مراكز بحثية للانكباب على استشراف المستقبل، ووضع صناع القرار امام استخلاصات الخبراء والمختصون وسيناريوهاتهم المختلفة للاستفادة منها في رسم الاستراتيجيات، وتعميق الخطط ذات الابعاد المتعددة لتطوير المجتمعات والامن الوطني والقومي والإنساني والحد من الاثار السلبية.
وحول التباين في وجهات النظر بيني وبين الدكتور عوض، عقب الدكتور عبد الرحمن التميمي في مداخلته داعما وجهة نظر الدكتور احمد، قائلا ان هناك اكثر من 150 جامعة تعتمد الدراسات المستقبلية ك"علم"، وتناسى ان عدد الجامعات في العالم حسب هيئة تقييم الجامعات الدولية في العالم بلغ حتى بداية عام 2011 ( 17716) جامعة ومعهد عالي يوجد منها ما يزيد عن 7000 في أمريكا الشمالية (خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا). وبالتالي برهان التميمي لا يعتبر سندا في الدفاع عن وجهة النظر، التي تبنها عوض وقطاع من الأساتذة الافاضل في الجامعات المذكورة.
وكما ذكرت هذه الظاهرة ليست جديدة، ولم تنشأ عام 1907 او 1920، وانما كانت سابقة على ذلك التاريخ. وان لم تأخذ هذه الصفة في الازمان الغابرة والسابقة، بيد انها صفة ملاصقة للانسان كفرد ومجتمع في تطوره. لكن عدم تسليط الضوء عليها يعود لاسباب تتعلق بتطور المجتمعات البشرية. جميعنا يعلم ان العلماء في الحقب التاريخية الغابرة كانوا يتميزون بسمة جمع العديد من العلوم في دراساتهم وكتاباتهم، وقدموا اسهامات غاية في الأهمية في الفلسفة والفلك والطب والاحياء والرياضيات، وكان لديهم استشرافاتهم المستقبلية في واقعهم المحدد، وعلى مستويات إقليمية ودولية وفق معايير تلك الازمنة ... إلخ ولكن لم يتم التعامل معها كظاهرة علمية.
واشرت في تعقيبي لموضوع الاستشراف للمستقبل واهميته، وأوردت 3 نماذج بشكل سريع، منها نموذج استشراف هرتزل الصهيوني عن إقامة الدولة الإسرائيلية بعد خمسين عاما في عام 1897، ويعتبر هذا من النماذج الحدسية، او كما عرفه المختصون "النموذج البديهي". ونموذج ثاني قدمه كارل ماركس، الذي استشرف وصول المجتمع البشري إلى المرحلة الاشتراكية استنادا لقراءة التطور التاريخي "المادية التاريخية" بالعلاقة مع "المادية الديالكتيكية" من خلال اعتماد "النموذج الاستكشافي"، كما جاء في الدراسة؛ والنموذج الثالث ما قدمتة دراسات الدكتور حامد ربيع عن "استشراف مستقبل الإسلام بين القوى الدولية خلال القرن الحادي والعشرين" انطلاقا من سؤال "هل يستطيع الإسلام ان يرتفع إلى مصاف القوى الدولية؟ باعتماده النموذج "الاستهدافي او المعياري" وحتى نموذج "التغذية العكسية" وفق ما تضمنته الدراسة مثار النقاش.
باختصار وحتى لا اطيل، تسليط الضوء على الدراسات المستقبلية، والاهتمام بها واغنائها، وترسيخها في استشراف المستقبل في ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية العسكرية والتكنولوجية وبالضرورة السياسية بات ضرورة للمجتمعات وصناع القرار فيها.
واتفق مع ما تضمنته الدراسة بشأن عوامل الضعف في الوطن العربي، وتغييبها هذه الظاهرة، وعدم ايلائها الاهتمام المطلوب، حتى ان اربعة أبحاث من سبعة حول قضايا العالم العربي ومصر وسوريا مولتها الأمم المتحدة، وهو ما يكشف عن خلل كبيرة في أوساط صناع القرار العرب، ليس هذا فحسب، بل انها لم تحاول ان تسهم في تمويل هكذا دراسات، ولم تعر الاهتمام الكافي لانشاء وتطوير مراكز أبحاث خاصة بدراسات المستقبل. الامر الذي يفرض على الأنظمة التي تدعي انها ديمقراطية ان تعمل على الاتي: أولا انشاء مراكز ومؤسسات بحثية خاصة بدراسة المستقبليات؛ ثانيا تأمين حرية الرأي والرأي الاخر للوصول للاستنتاجات والاستشرافات المستقبلية؛ ثالثا تأمين التمويل المطلوب لها؛ رابعا تأمين الوصول للمعلومات بحرية ودون قيود لبلوغ الهدف المرجو منها ... إلخ
ظاهرة الدراسات المستقبلية اكثر من مهمة للشعب العربي الفلسطيني، واحوج ما يكون لها هو صانع القرار الفلسطيني، الذي تملي عليه مصالحه وحساباته واستقراءه للمستقبل إيلاء الاهتمام اكثر فاكثر لتأسيس وانشاء المراكز البحثية المختصة بالدراسات المستقبلية، وتقديم كل عوامل النجاح والتطور لها. وبالمحصلة لا املك سوى تقديم الشكر لمركزي الدراسات الفلسطينيين وللقائمين عليها لايلائهما الدراسات المستقبلية الأهمية التي تستحق.
[email protected]
[email protected]